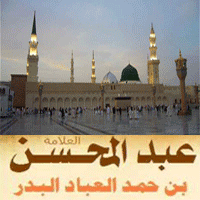هذه هي المحاضرة السابعة للدكتور سارة، وما زال الحضور هو الحضور، وكثر الحديث عن هذه المحاضرات، في بعض المنتديات، إضافة إلى كتابات في صحف ومجلات، تضمنت بمجموعها الثناء عليها، وإن ظهر في بعضها نقد لها، بحجة أنها تتوسع في إيراد النصوص وفي التحليل أحياناً، واحد فقط ممن كتب عن هذه المحاضرات، قال إنها عاطفية.
قد علق كاتب في جريدة الجامعة، وقال هناك خلط بين العاطفية والعائلية، فهذه المحاضرات كأنها وجبات عائلية، تصلح أن يتداولها أفراد العائلة جميعاً، لكنها تبقى فيما يبدو وجهات نظر، كانت هي نفسها محل أعجاب البعض الآخر، بخاصة أولئك الذين لديهم اهتمامات مسبقة بهذا الموضوع.
لم يصدر عن الدكتورة سارة تعليق قط، على ما قيل بشأن محاضراتها هذه، وهو ما استرعى انتباه كثير من المتابعين، وكان بودهم، أن يسمعوا منها شيئاً، لكن لم يشأ أحد منهم أن يطرح هذا الموضوع، أو يسأل عنه.
افتتحت الدكتورة سارة محاضرتها، كعادتها بالترحيب بالحضور، ثم بدأتها قائلة :
سبق الحديث في محاضرة سابقة، عن صلة الأخلاق بعضها ببعض، وقد نقلنا حينها رأي بعض علماء الأخلاق، والذي جاء فيه أن الشخصية الإنسانية ليس بمقدورها أن تبرز في خلق معين، ليصبح علامة فارقة لها مالم تمارس هذه الشخصية ابتداءً غيرها من الأخلاق، وتتلبس بالقيم عامة، وذكرنا حينها مقولة بعض العلماء، إن الأخلاق يقوي بعضها بعضاً، وهو ما يشهد للرأي السابق.
أردت أن تكون هذه الأسطر، مقدمة لموضوع اليوم، ولعلكم تذكرون أن أحد الحاضرين المح إليه قبل عدة محاضرات، وقلت له حينها إنه جانب أصيل من موضوعنا، وسوف نعرض له بشيء من التفصيل.
ولكن يبدو لي أني مضطرة قبل أن أعرض لهذا الموضوع، ولصور الرحمة المصاحبة له، إلى أن أتحدث قليلاً عن فلسفة الحرب في سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، ولا أخفي عليكم أني لا أرغب في الحديث عن الحروب، وأحسب أنكم تبادلوني الشعور نفسه، ولا تحبون الاستماع إلى ما يتصل بهذه الحروب، التي زكمت الأنوف، برائحتها الكريهة، في عصر خبثت فيه السرائر وعميت فيه البصائر.
لقد أصابنا اكتئاب من أخبار الحروب، والمناظر المصاحبة لها، من دماء وأشلاء، ودمار حتى يُخيل لنا أن البشرية فقدت صوابها، ولم تعد تدري لماذا القاتل يقتل، ولمَ المقتول قتل، ولا لمَ الظالم ظلم، ولا كيف المظلوم انتقم.
إن كراهيتنا للحرب، وأخبارها، وآثارها، لهي من أهم الأسباب التي دفعتنا للحديث عن الأخلاق، وبخاصة خلق الرحمة منها، لتذكر البشرية التائهة، أن ثمة خلقاً في الأرض يسمى الرحمة، قد يغني في مواطن كثيرة عن الحرب، والكراهية، ولتعلم البشرية أيضاً أن ثمة شخصاً تمثلت الرحمة في سيرته كلها، وكانت السلاح الذي حارب به خصومه، في مواطن عدة ، حين حاربوه بالقوة والقسوة، والوسيلة التي جذب فيها كثير من الناس إلى دعوته، ونجح في نشر ثقافة الرحمة بين الناس.
لكن ما العمل إذا كان الحديث عن الرحمة، يمر أحياناً عبر الحديث عن الحرب، وما فيها من هم وكرب، وأرجو أن لا يفهم أننا ننساق خلف العاطفة، ويغلبنا الشعور بالإنسانية، لدرجة أننا نتجاهل قضية الصراع بين الخير والشر في هذه الدنيا، أو نتغافل عن الأسباب التي تؤدي إلى الصراعات سواء ما كان منها مقنعاً أو غير مقنع، مشروعاً أو غير مشروع.
أود أن أعرض ما لدي عن موضوع الحرب في سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على هيئة نقاط، حتى لا يأخذنا الحديث إلى حيث لا نريد، بخاصة أننا أمام موضوع تضطرب فيه الآراء، وتؤثر فيه الأهواء.
أولا : لقد ثبت لدي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أذن بالقتال لأصحابه بعد مرور خمسة عشر عاماً على دعوته، فإن القتال شرع في السنة الثانية من الهجرة، على قول أكثر العلماء(1). وهذا يعني أن السنوات التي حارب فيها ثمان سنوات فقط ، لأن دعوة النبي (صلى الله عليه وسلم) كما لا يخفى، كانت ثلاثة وعشرين عاماً.
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الثقافة السائدة آنذاك، تنص على حرمة القتال في الأشهر الحرم، وهي أربعة (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) (التوبة : 36 ).
وكانت هذه الثقافة محل احترام المسلمين، وخصومهم، إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار، كما أسلفت يسقط من الثماني سنوات قرابة ثلاث سنوات، وهي مجموع أربعة أشهر من كل سنة على مدى ثماني سنوات، فتكون المدة الإجمالية التي يمكن للنبي (صلى الله عليه وسلم) أن يقاتل فيها عدوه هي خمس سنوات فقط من سيرته الطويلة التي امتدت ثلاثة وعشرين عاماً كما أسلفت.
ثانياً : إن عدد المعارك التي خاضها النبي (صلى الله عليه وسلم)، بلغ تسع معارك فقط، إضافة إلى نشاطات قتالية محدودة، كان يكلف بها أعداداً من أصحابه لإنجاز مهام محددة، لم يكن في أغلبها قتل أو قتال.
لقد اجتهد عدد من العلماء في إحصاء الخسائر البشرية للمعارك التي حصلت في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)، وحصل تضارب في الأرقام التي وردت عنهم، وكان أعلى هذه الأرقام لا يزيد على 1048 شخصاً من الأطراف جميعها، ولعل ثمة اعتبارات كان لها أثر في إحصاء كل باحث، ولكن ثبت لدي أن العدد لا يتجاوز المئات، على أعلى تقدير، خلال ثماني سنوات، وفي تسع معارك، وعدد من الحملات الصغيرة المحددة.
أما ونحن في مجال ذكر الأرقام، فلا بأس أن نذكر عدد من قتلوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية فقط .
الحرب العالمية الأولى، أو الحرب العظيمة، أو الحرب التي أنهت جميع الحروب، هي تلك الحرب التي قامت بين عامي 1914م إلى 1918م، تم استعمال الأسلحة الكيميائية، في تلك الحرب، لأول مرة، ولم يحرك العالم عدداً من الجنود، مثلما حرَّك في الحرب العالمية الأولى، وتم قصف المدنيين، من السماء لأول مرَّة في التاريخ، وتمت فيها الإبادات العرقية: ( 9 مليون عسكري، 7 مليون مدني، المجموع 17مليون نسمة).
الحرب العالمية الثانية، بدأت في عام 1937م، في آسيا، وفي عام 1939م في أوروبا، وانتهت الحرب في عام 1945م، باستسلام اليابان، تعد الحرب العالمية الثانية من الحروب الشمولية، وأكثرها كلفة في تاريخ البشرية، لاتساع بقعة الحرب، وتعدد مسارح المعركة، فكانت دول كثيرة، طرفاً من أطراف النزاع، فقد حصدت الحرب العالمية الثانية زهاء 60 مليون نفس بشرية، بين عسكري ومدني: ( 25 مليون عسكري، 37 مليون مدني).
نعم أعزائي الحضور، اسمعوا بكل حسرة وألم 77 مليون شخص قتلوا في حربين فقط، خلال 12 عاماً تقريباً، منهم 44 مليون مدني، يعني أكثر من ثلثي القتلى من المدنيين.
وفي عصر الرحمة في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) قتل قرابة 1000 شخص من الطرفين، لا يكاد يوجد بينهم مدني، في تسع معارك كبيرة، ومواجهات صغيرة ، على مدى 23 سنة من مواجهة النبي (صلى الله عليه وسلم) لخصومه.
واسمحوا لي أن أكرر في هذا المقام، بعد الذهول الذي أصابنا من هذه الأرقام، عبارة د. نعوم تشوسكي ( لقد انتزعت هذه الحقائق من التاريخ، وعلى المرء أن يصرخ بها، ويعلنها على رؤوس الأشهاد)(1).
ثالثاً : إن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يتجنب القتال ما وجد إلى ذلك سبيلاً، اجتناب القوي ذي الإمكانات، لعلمه أن دعوته حققت، وتحقق نجاحات كثيرة، دونما حاجة إلى قتال، وهذه حقيقة أكدتها خمس عشرة سنة مضت دون قتال، وكانت زاخرة بالإنجازات.
ولا بأس أن نمثل لصحة هذا التوجه، بما حصل في أول معركة خاضها النبي(صلى الله عليه وسلم) مع خصومه في مكة، فقد خرج لا يريد قتالاً، وهذه حقيقة سجلها القرآن الكريم ، حين قال في شأنه وشأن أصحابه: (وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ) (الأنفال : 7 )، فكشفت هذه الآية، عن عدم رغبة النبي (صلى الله عليه وسلم) في القتال. لكنه لما وصل اضطر إليها، ولم يجد منها بداً، وما كان للنبي (صلى الله عليه وسلم) أن يهرب من وجه عدوه بحال.
وتمنى قبيل بدء المعركة بساعات، أن تؤوب قريش إلى رشدها، وتعدل عن المواجهة، ويدل على هذا بوضوح قول النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل بدء المعركة بساعات لمن معه ( إن كان عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا)(1). ويعني به عتبة بن ربيعة، الذي كان يسعى لإقناع قريش بالعدول عن الحرب، لكنه لم يتمكن، وغلبه على رأيه أبو جهل وأضرابه.
كان أحياناً يغير طريقه تجنباً للقتال، كما حصل حين توجه مع أصحابه إلى أداء العمرة، وكان يجعل بينه وبين خصومه وسيطاً ليقنعهم بأضرار الحرب، ورغبته في السلام، وهو ما حصل قبيل صلح الحديبية(1).
وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) يفضل عقد المعاهدات مع خصومه، ويسارع في إبرامها ليغلق الباب أمام الحرب، وتكاد المعاهدات تبلغ عدد الغزوات، وما هذا إلاَّ لحرصه على تجنب الحرب.
رابعاً : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا اضطر إلى القتال، فلا يقاتل إلاَّ دفاعاً عن النفس أو الأرض، حتى وإن بدأ هو بالقتال ، فإذا سمع بخطر داهم، أو بلغه أن قوماً يعدون العدة لقتاله، سعى لقتالهم، وهو بهذا يلتزم التوجيه القرآني الواضح: (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم
هنا رفعت إحدى الحاضرات يدها، فأذنت لها بالكلام، فعرَّفت بنفسها بصوت غير مسموع، وقالت إنها تعمل في مجال رعاية الطفولة، ولديها معلومة مفيدة، في هذا المجال، ترغب في ذكرها، فرحبت الدكتورة بعرضها. فقالت المتحدثة:
قرأت في بحث كان قد قُدم إلى ندوة حول الطفولة، وعندي في مكتبي نسخة منه، قرأت فيه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يمنع خروج الأطفال معه إلى القتال.
فقد حدث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما خرج إلى معركة بدر، نظر إلى الجيش، وإذا فيه غلامان صغيران، هما عبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، فأمرهما النبي (صلى الله عليه وسلم) بالعودة إلى المدينة(2)، مع أنهما حاولا الوقوف على رؤوس الأصابع والتطاول ليبدوان كبيرين، ولكن لم تفلح خطتهما، فقد أصر النبي (صلى الله عليه وسلم) على عودتهما، مع أنه لم يكن يجزم بإنه سوف يقاتل، ولكن تحسباً لوقوع قتال، كان لابد من تجنيب الأطفال هذه المخاطر رحمةً بهم.
ثم وقفت صاحبة المداخلة وقالت: هل تسمحين بالمواصلة، أجابتها الدكتورة حالاً نعم، نعم تفضلي واصلي حديثك، ولكن اسمحي لي بدقيقة واحدة، أذكر فيها ـ حتى لا أنسى ـ أن نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)، كان حريصاً على جنس الأطفال وليس على أطفال المسلمين فقط، فقد نهي بشدة ، أن يقتل أحد من أطفال الأعداء، حين قال لخالد بن الوليد (رضي الله عنه)، أحد قواده ( لا تقتل وليداً، ولا امرأة، ولا عسيفاً)(1) أي خادماً
واصلت صاحبة المداخلة حديثها، فقالت: في مقابل هذا فقد نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) أن 300 ألف طفل يعملون جنوداً في الجيوش ويشاركون في المعارك(2).
وسبق أن ذكرتِ لنا في المحاضرة الأولى، أن منظمة أطباء العالم غير الحكومية، ذكرت أنه قتل أكثر من 2 مليون طفل خلال السنوات الماضية، من جراء الحروب والصراعات.
وهذا يشجعني على أن اقترح أن يضاف إلى النقاط التي تفضلتِ بذكرها، نقطة تتحدث عن حرص النبي (صلى الله عليه وسلم) على إبعاد المدنيين من أطفال، ونساء، عن الحروب، ولهذا لم يكن في حروبه ضحايا مدنيون.
بعد أن استمعت الدكتورة إلى هذا الحديث، بكل عناية واهتمام، قالت للمتحدثة، أرجو منك أن تتفضلي إلى المنصة عندي، لإعادة هذا الكلام الرائع، والذي اعتبره جزءاً مهماً من محاضرتي، وسوف أثبته فيها.
ترددت المتحدثة بتلبية الدعوة، وحاولت الاعتذار، لكن الدكتورة أصرت عليها، لسبب وجيه، قائلة إن أغلب الحضور لم يستمعوا إلى كلامك المفيد، فصار حضورك إلى المنصة ضرورياً، لتعم الفائدة، حيث إني رأيت أن يكون كلامك هذا هو النقطة الخامسة ضمن هذه النقاط، تقدمت المتحدثة على خجل، وأعادت كلامها أمام الحضور، الذي قابله بإعجاب واستحسان.
وما أن انتهت من كلامها، حتى شكرتها د. سارة مرة أخرى باسمها، واسم الحضور، وما أن انتهت المتحدثة من مداخلتها، حتى وقف أحد الحاضرين، وقال يبدو أن الوضع العام يشجع على المداخلات، فأرجو أن تسمحي لي بذكر شيء طريف أعجبني، يدل على حرص النبي (صلى الله عليه وسلم) على الأطفال، وحرصه عليهم. فقالت له تفضل، فقال روى أنس بن مالك (رضي الله عنه) ، أن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال للآباء والأمهات ( كفُّو صبيانكم عند فحمة العشاء، وفي رواية إذا غابت الشمس )(1) ، فأنا أفهم من هذه النصيحة النبوية، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يرغب أن يأوي الأطفال إلى البيوت قبل مجئ الليل، لأن الليل لا يخلو من مخاطر متنوعة. قد تعرِّض الأطفال للأذى.
فأي رحمة أظهر من هذه التي يبديها النبي (صلى الله عليه وسلم) تجاه الأطفال، نتمنى أن نرى مثل هذا التوجه عند أولياء الأمور في عصرنا هذا، وشكراً لكِ على إتاحة هذه الفرصة .
شكرت د. سارة المتحدث على هذه المعلومة الطريفة المعبرة، وطلبت إدراجها ضمن مادة المحاضرة ،وقالت:
لقد تذكرت حادثتين يحسن ذكرهما هنا، فهما مناسبتان لهذا المقام.
الأولى : وقد مرت بنا، وهي قصة أول شهيدة في الإسلام، سمية بنت خباط، فإن أعداء النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يترددوا في قتل امرأة ، في حين لما رأي النبي (صلى الله عليه وسلم) في إحدى معاركه امرأة من أعدائه مقتولة، غضب ونهى عن قتل النساء.
فقد مرَّ النبي (صلى الله عليه وسلم) بامرأة مقتولة في غزوة حنين، والناس مزدحمون حولها، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) ما هذا ؟ قالوا امرأة قتلها خالد بن الوليد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما كانت هذه تقاتل، وقال لبعض من معه، أدرك خالداً فقل له إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيفاً يعني خادماً.
ما أن انتهت من كلامها، حتى استدرك أحد الحاضرين قائلاً: لقد قرأت أن المرأة كانت تخرج مع النبي (صلى الله عليه وسلم) في حروبه، فهل هذا صحيح، وإذا صح، كيف نوفق بينه وبين ما تفضلتم بذكره.
قالت هذا صحيح، فقد وقفت على نصوص تدل على هذا، وأنا أقرأ عن موقف النبي (صلى الله عليه وسلم) من المرأة، ولكن ما ينبغي أن يعرف هنا، أن المرأة كانت تبقى في مؤخرة الجيش، تسهم في تقديم العلاج والماء، وكانت بعيدة في الأصل عن ميدان القتال، وفي هذا تكريم لها، حين أعطيت الفرصة لتقديم خدماتها، وفيه رحمة بها، حين أُبعدت عن القتال.
أرغب أعزائي الحضور في العودة قليلاً إلى موضوع عدم سماح النبي (صلى الله عليه وسلم) للأطفال بمرافقته إلى ساحة القتال فإنه لا يحسن بأحد أن يتملكه العجب، وهو يرى هذه الصورة الحانية على الأطفال من النبي الكريم الرحيم.
لقد كان من مظاهر رحمته أن يطيل في سجوده حرصاً على طفل ركب على ظهره وهو ساجد, مخافة أن يسقط عن ظهره، وهذا الطفل هو ابن بنته فاطمة(1).
الثانية : أن أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) رأوه يحمل الطفلة، أمامة بنت ابنته زينب، فإذا سجد وضعها على الأرض بجانبه، وإذا قام حملها معه(2)، وربما كان يفعل هذا مخافة أن يلحق بها أذى رحمةً منه بها، وشفقة عليها، فهل يتصور ممن هذا تعامله مع الأطفال، أن يسمح لهم بالذهاب معه إلى القتال.
أعزائي الحضور ..
إن هذا النبي الرحيم (صلى الله عليه وسلم) الذي أبى أن يرى أماً من الطير تفجع بفرخيها الصغيرين، فأمر أصحابه برد فرخيها إليها، كما مر بنا لا يتصور منه بحال أن يفجع أماً من بني البشر بولدها، ولهذا رد الغلامين كما أسلفنا.
اسمحوا لي أن أوجه باسمي واسمكم، نداءً عاجلاً، ونصيحة خالصة إلى البشرية، للبحث عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، فإن لم تجده بشخصه، فإنها قطعاً ستجده من خلال مبادئه السامية، التي لم تكن البشرية أحوج إليها، كما هي في أيامها هذه.
يفهم من هذا المسلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يقاتل أفراداً، وإنما كان يقاتل سلطة، إذا تركت قد تشكل خطراً على الإسلام وأهله، فكان لابد من إزالتها، لفتح المجال أمام الأفراد لاتخاذ ما يناسبهم من قرار، ومنحهم فرصة الاختيار دونما مؤثرات خارجية.
يقول الأستاذ العقاد ( إن الإسلام إنما يعاب عليه، أن يحارب بالسيف، فكرة يمكن أن تحارب بالبرهان، والإقناع، ولكن لا يعاب عليه أن يحارب بالسيف سلطة تقف في طريقه، وتحول بينه وبين أسماع المستعدين للإصغاء إليه، لأن السلطة لا تزال إلاَّ بالسلطة، ولا غنى في إخضاعها عن القوة)(1).
لقد سبق الحديث في محاضرة سابقة، أن المبادئ تحتاج إلى قوة، تساندها في مواطن كثيرة، لا لفرضها على الناس، ولكن لحمايتها، وإزالة العقبات من أمامها.
إن الغرب لم يلتزموا بالمنهج الذي وضعه السيد المسيح، والقائم على أن من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ولقد شهد التاريخ على مدى عدة قرون، حروباً باسم المسيح، وهو منها براء، راح ضحيتها ملايين البشر، وليس من أحد ينكر هذه الحقائق المؤلمة، ولا أود التوسع في هذه القضية.
سادساً : كان للنبي (صلى الله عليه وسلم) نظام متميز في تجهيز الجيش، لمواجهة خصومه، فلم يكن يجبر أحداً على الخروج معه، وكان يأذن لمن يريد التخلف عنه حين يبدي أعذاراً شخصية، حتى وصل الأمر إلى أن يعاتبه الله تعالى قائلاً له : (عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ) (التوبة : 43 )، كأن النبي (صلى الله عليه وسلم) توسع في قبول الأعذار، حتى استغلها من لا عذر له أصلاً، وهم المنافقون، فجاء العتاب ليظهر الصادق من الكاذب.
لا يتعارض هذا التصرف مع رغبته في خروج أصحابه معه إذا خرج، ولقد بدا منهم الحرص الشديد على الخروج معه، حتى إنه كان يحدث خلاف بين الابن وأبيه في أيهما يخرج لرغبة الاثنين في مرافقة النبي (صلى الله عليه وسلم) ، كما حصل مع سعد بن خيثمة وابيه يوم بدر(1)، وكما حصل أيضاً خلاف بين أبي أمامة وخاله في أيهما يبقى مع أم أبي أمامه المريضة، وقد مرت بنا هذه الحادثة.
إن الخروج عن رغبة واختيار،غير الإكراه على الخروج دونما اعتبار لظروف، وهو الذي نراه في الجيوش المتحضرة في الوقت الحاضر، حين يساق الجنود إلى المعارك سوقاً، وأكثرهم لها كارهون.
اتضح هذا المسلك جلياً، أيضاً حين طلب النبي (صلى الله عليه وسلم) من أحد القادة وهو عبد الله بن جحش، أن لا يكره أحداً على السير معه، فقد كتب له كتاباً، جاء فيه ( سر حتى تأتي بطن نخله على اسم الله وبركاته، ولا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير معك)(1).
كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يأذن لأفراد بالتخلف عن الخروج للقتال معه، لأسباب شخصية، ذكرنا بعضها، وكان أحياناً يطلب من بعضهم التخلف، كما حصل مع عثمان بن عفان (رضي الله عنه) فقد أمره أن يتخلف عنه بسبب مرض زوجته(2)، وإذن لأبي أمامه بل طلب منه أيضاً أن يتخلف عنه ليبقى بجانب أمه المريضة، ومثل هذا كثير.
إن هذه السلوكيات عندما يجتمع بعضها إلى بعض، تشكل معلماً بارزاً، يدل بوضوح على أن القتال لم يكن هدفاً ملحاً للنبي (صلى الله عليه وسلم) ولا غاية في حد ذاته، فإنه لم يكن يوماً متعطشاً لقتل، أو قتال، ولم يغب عنه لحظة، أنه أرسل رحمة للناس، وأنه سوف يستعين بهذه الرحمة أكثر من استعانته بالسلاح، لمواجهة خصومه في بعض الميادين، وقد حصل هذا بالفعل.
إن مقولة علماء الأخلاق ( إن الأخلاقية تعني فن السيطرة على الأهواء) تتحقق بجلاء في الفلسفة القتالية لدى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) فأين هو من كثير من القادة العظام، الذين عرفتهم البشرية، أمثال الاسكندر المقدوني، وهولاكو، ونابليون، وهتلر، وغيرهم ممن لا نستحضر ذكرهم.
قد قاتل هؤلاء جميعاً أناساً لا يوجد بينهم وبين هؤلاء القادة قضية، ولا خصومة أصلاً، لكن الدوافع الدنيوية، كالشهرة، والمصالح العامة والخاصة، جعلت هؤلاء القادة يدخلون أرضاً ليست أرضهم، ويقاتلوا أناساً أبرياء، ليسوا خصماً لهم، وكانت النتيجة قتل مئات الألوف، وتدمير مئات المدن، والمحصلة النهائية مزيد من القتل والدمار وعدم الاستقرار.
أما النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) فإن قاتل، فإنه يقاتل من قاتلوه، وقاتلوا أتباعه، وأخرجوهم من أرضهم، وأخذوا أموالهم، فإنه في عرف الشرائع جميعها، محق فيما يصنع، ومع هذا لم يصدر منه تصرف واحد يدل على أنه صاحب شهوة، أو باحث عن شهرة في هذا الميدان.
دعا كل من المسيح والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى الرحمة، والتسامح بين الناس، وأحسنا أيما إحسان ، لكن المسيح لم يتمكن من نشر ما يدعو إليه، ولا من تحقيقه على أرض الواقع، على الهيئة التي كان يريدها، لأنه لم يجد قوة تحمي الرحمة، وتفسح الطريق لها لتصل إلى الناس جميعاً، بسبب عداوة اليهود له، ووجود سلطة الرومان القاسية.
بيد أن النبي محمداً (صلى الله عليه وسلم) وجد هذه القوة، وأزال بها العقبات التي تقف في وجه انتشار هذه المبادئ السامية، كان استخدام النبي (صلى الله عليه وسلم) للقوة في بعض المواطن، دليلاً على شدة حرصه على نشر ثقافة الرحمة، والتسامح، والعدل، والإحسان، وإلاَّ كان بإمكانه أن يدعو إلى هذه الأخلاق، كما دعا غيره ممن سبقه من العظماء، ثم يترك الناس وشأنهم، من شاء تخلق بها، ومن شاء أعرض عنها، وعمل بنقيضها .
ما كان لنبي الرحمة المرسل رحمة للناس أن يسلك هذا المسلك بحال لأن البشرية ستكون الضحية، والإنسانية ستدفع الثمن غالياً، لقد كان قتال النبي (صلى الله عليه وسلم) رحمة، كي تسود بين الناس الرحمة، بلا عقباتٍ أو حدودٍ .
أعزائي الحضور ..
تجمع لدي معلومات ومقولات في أثناء إعدادي لهذه المحاضرات، احتفظ بها في أوراق جانبية، وكثيراً ما أجدني راغباً في اطلاعكم عليها، لأنها تكشف عن جانب من الإنصاف في دراسات من كتبوا عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من غير أتباعه، كما إنني أستأنس بعرضها، لأنها بصراحة تبعث الثقة في نفوس كثير من المستمعين، لهذا كله اسمحوا لي أن ألقي على مسامعكم هذه الأقوال لباحثين كبار لها صلة وثيقة بموضوعنا هذا، واعتذر مسبقاً إن كنت قد ذكرت بعضها في محاضرات سابقة.
يقول المستشرق الاسباني جان ليك ( لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
ويقول الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل ( لدى محمد ذلك الرجل الكبير العظيم النفس المملوءة رحمة وخيراً وحناناً أفكـار غـير الطـمع الدنيـوي ونوايا خـلاف طلـب السلطة والجاه)(2).
ويقول كارليل أيضا ( لم تخل الحروب الشديدة التي وقعت له مع الأعراب من مشاهد قوة، ولكنها كذلك لم تخل من دلائل رحمة وكرم وغفران، وكان محمد لا يعتذر من الأولى ولا يفتخر بالثانية)(3).
ويقول المفكر اللورد هدلي ، وهو يعلق على معاملة النبي (صلى الله عليه وسلم) لأسرى معركة بدر ( أفلا يدل هذا على أن محمداً لم يكن متصفاً بالقسوة، ولا متعطشاً للدماء، كما يقول خصومه، بل كان دائماً يعمل على حقن الدماء قدر المستطاع)(1).
ويقول العلامة الألماني برتلى سانت هيلر ( كان النبي داعياً إلى ديانة الإله الواحد، وكان في دعوته هذه لطيفاً، ورحيماً، حتى مع أعدائه، وإن في شخصيته صفتين هما من أجل الصفات، التي تحملها النفس البشرية، وهما العدالة، والرحمة)(2).
أعزائي الحضور .. ما زال الحديث موصولاً، بممارسة النبي (صلى الله عليه وسلم) الرحمة بكل مظاهرها، ولكن في ميدان آخر، يوم أن كثر أتباعه، وعظمت قوته، وتتابعت انتصاراته في هذه الأجواء ظهرت صور للرحمة باهرة من النبي (صلى الله عليه وسلم) لأعدائه الذين كانوا يناصبونه العداء، كانت موضع إعجاب، وربما تعجب.
ولا أخفي عليكم، أن من أسباب تتبعي لهذا الموضوع، وحرصي على الوقوف على هذه الأحداث، هو ما قرأته لبعض الكتَّاب الغربيين، من أن النبي محمداً (صلى الله عليه وسلم) كان في مكة، نبياً متسامحاً، ولما ذهب إلى المدينة، صار حاكماً ورئيساً لدولة، يتصرف كما يتصرف الزعماء(3)
اسمحوا لي أن أعود بكم إلى مكة، حين أقدمت قريش على عزل النبي (صلى الله عليه وسلم) وأتباعه وأقربائه، في وادي يسمى شعب أبي طالب، مدة ثلاث سنوات، منعوا عنهم الطعام، وحرموا الاتصال بهم، حتى أشرفوا على الهلاك هم ونساؤهم وأطفالهم، وربما أكل بعضهم الحشرات، والديدان من شدة الجوع(1).
وتمضى الأيام، ويهاجر النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة، ويقيم دولة قوية يحسب لها ألف حساب، وإذا بثمامة بن أثال زعيم بني حنيفة من بلاد نجد يدخل في الإسلام، ويقرر من نفسه دعم موقف النبي (صلى الله عليه وسلم) وضعاف أعدائه في مكة، فيتخذ قراراً بوقف تصدير القمح إلى قريش، ومعلوم أن مكة ليست أرضاً زراعية.
بدأ الرعب يدب في قلوب أهل مكة، حين هاجمهم شبح الجوع، فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)،وقيل أرسلوا إليه وفداً، يرجونه أن يتدخل لدى ثمامة ليعاود تصدير القمح إليهم.
كان أهل مكة يعلمون أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن في يوم من الأيام، قاسي القلب، أو جاسي الطبع، ولهذا قصدوه، في هذا الطلب، رغم خصومتهم له.
كأني بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) تعود به الذاكرة إلى سنوات خلت، يوم أن حوصر هو وأتباعه وأهله من هؤلاء الذين يرجونه هذا الرجاء، الآن ويذكرونه بما بينهم من رحم، هذا الرحم الذي غاب عنهم يوم أن حاصروه ومن معه، وإذا بالرحمة تتحرك، ويكتب النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى ثمامة أن يعود إلى ما كان عليه من تصدير القمح إلى قريش.
كان بمقدور النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يعاملهم بالمثل، ويتركهم يعانون من الجوع، بخاصة أنه لا يد له في هذا الأمر، فإنه لم يأمر به، ولم يستشره ثمامة حين منع القمح عنهم.
لقد أبت رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يعامل قريشاً بالمثل، وهو قادر على هذا، ويتكرر المشهد، حين أصاب قريشاً جدب شديد، كادت تهلك من الجوع، وإذا بهم يرسلون وفداً يطلبون من النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يدعو الله أن يرفع عنهم هذا الجدب.
ويستجيب النبي (صلى الله عليه وسلم) لطلبهم هذا، ويدعو الله ربه، وتتحقق الاستجابة، ويزول عن قريش هذا البأس الشديد(1).
ينتاب المرء وهو يعيش مع هذه المواقف، شعور ممزوج بالعجب والسخرية من قريش، وربما بالضحك أيضاً، فإن خصوم النبي (صلى الله عليه وسلم) هؤلاء يعترفون برحمته، ويشاهدون مظاهرها، ويعلمون أن النبي (صلى الله عليه وسلم) يقدم الرحمة في كل موطن، ولهذا جاءوا إليه يتوسلون أن يعمل على رفع شبح الجوع عنهم، وعن نسائهم، وأطفالهم، عن طريق الدعاء، ومن خلال التوسط لدى ثمامة.
لقد كانوا على يقين أنه فاعل، ما طلبوا، ولقد فعل، ومع هذا استمروا في عداوتهم، وهنا أعود وأذكركم بمقولة الأستاذ العقاد، إن الناس اجترؤوا على العظمة بقدر حاجتهم إليها(2).
لقد مارس النبي (صلى الله عليه وسلم) الرحمة في بيئة تفتقدها، لكنه نجح في توظيفها لحل مشاكله مع خصومه، ويؤسفني القول مستمعي الكرام، إن هذه الرحمة ما زالت مفقودة ومعيبة في بيئات معاصرة، هناك من يحول دون ممارسة الناس للرحمة، والشعور بها، والسعادة بممارستها، حين يزين لهم المتلاعبون بالعقول، والعابثون بالعواطف، أن مصلحة هؤلاء الناس لا تتحقق إلاَّ بالقتل والتدمير، وإن أمنهم مهدد مالم يتم الذهاب شرقاً وغرباً للقتل والتدمير.
ألا يمكن لمن أوتي قوة ومالاً وإمكانات أن يحل مشاكله إن وجدت ـ عن طريق المحبة والرحمة، وعندها يسعد القوي حين يمارس الرحمة، ويسعد الضعيف حين ينعم بآثارها الطيبة.
لقد قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) نماذج للإنسانية، ستكون سعيدة للغاية لو التفتت إليها.
أذكر في هذا المقام عبارة جميلة قالها ديكارت، جاء فيها أن النبلاء أسياد غضبهم، وأن المتعجرف عبد لرغباته(1)، أي نبل أعظم من هذا، حين ترى الرحمة توجه مواقف النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أشد أعدائه، صدق علماء الأخلاق، حين قالوا إن الرحمة ليست مجرد كلمة أو شعور ينتاب المرء، وإنما هي سلوك، وواقع له مظاهره(2).
وتمضي الأيام، ولا تتعظ قريش، ولا تقدر مواقف النبي (صلى الله عليه وسلم)، فلما حصل صلح الحديبية بين النبي، وبين قريش وضعت قريش شرطاً صعباً على المسلمين شعروا أن فيه إهانة لهم.
يقول هذا الشرط إذا خرج أحد من أهل مكة مسلماً ولحق بالنبي (صلى الله عليه وسلم) في المدينة فيجب على النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يرده إلى أهله في مكة، والعكس لا يكون كذلك، فيوافق النبي (صلى الله عليه وسلم) على هذا الشرط الشديد على النفوس.
أسلم عدد من شباب مكة أمثال أبي بصير وأبي جندل، ولحقوا بالنبي (صلى الله عليه وسلم) في المدينة، فطلبت قريش ردهم إليها، فطلب منهم النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يغادروا المدينة تنفيذاً لشرط المعاهدة .
خرج هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم من المدينة، لكنهم لم يرجعوا إلى مكة، وإنما تجمعوا، وكانوا أقل من مئة بقليل في منطقة بين مكة والمدينة تسمى العيص، وصاروا يعترضون تجارة قريش المتجهة إلى الشام، فيقتلون من فيها من الرجال، ويأخذون الأموال، حتى كادت تتعطل تجارة أهل مكة، وشعروا أنهم في وضع سيء جداً لا يحسدون عليه.
مرة أخرى يرسل أهل مكة إلى النبي وفداً يتوسل إليه أن يرحم حالهم، وأن يطلب من هذه المجموعة أن تأتي عنده إلى المدينة، ويعلن خصوم النبي (صلى الله عليه وسلم) هؤلاء على الملأ أنهم تخلوا عن شرطهم، وإذا بالنبي (صلى الله عليه وسلم) يستجيب لهذا الرجاء، ويرحم حالهم، ويطلب من هذه المجموعة أن تترك موقعها وتأتي إلى المدينة(1).
لقد واجهت قريش النبي (صلى الله عليه وسلم) ومن معه بكبريائها وبشروطها التعسفية، وإذا بها تهزم، وتأتي إليه ذليلة، وإذا بالنبي يرد عليهم المواجهة بالرحمة، حين يشعر بأحوالهم المعيشية السيئة بسبب تعطل تجارتهم، فيطلب عدم التعرض لهم.
أعزائي الحاضرين ..
ألا يمكن القول إن النبي محمداً (صلى الله عليه وسلم) حارب أعداءه بالرحمة، وانتصر عليهم في مواطن عدة بها، وحاربهم كذلك بالتفضل عليهم، وعدم معاملتهم بالمثل، ورغبهم بالدخول بالإسلام، من خلال ممارسته لها، فهذا الحارث بن هشام يقول يوم فتح مكة، كنت أتوارى من النبي (صلى الله عليه وسلم) خجلاً منه، بسبب عداوتي له، قال ثم تذكرت بره، ورحمته، فلقيته في المسجد، وأسلمت، ففرح بي فرحاً شديداً(1).
إليكم هذه الحادثة الشهيرة، التي تؤكد بوضوح وجلاء ما قلته آنفاً، مرت ثماني سنوات على إخراج النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه من مكة، حين تركوها مكرهين، بسبب اضطهاد كفار قريش لهم، تركوها ولم يتمكن أحد منهم أن يأخذ معه شيئاً من أمواله.
لقد وصفهم القرآن وصفاً مؤثراً حين قال: (لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ
بعد هذه السنوات الثمان ، عاد النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى مكة، ومعه عشرة آلاف من أصحابه بكامل عدتهم وعتادهم، دخلها على رأس هذه القوة العظيمة، وليس يدور في ذهنه إلاَّ الرحمة، وهو في طريقه إلى مكة، بلغ النبي (صلى الله عليه وسلم) أن أحد قادته العسكريين، وهو سعد بن عبادة، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) بل اليوم يوم المرحمة، وأخذ راية القيادة منه، وسلمها لابنه قيس بن سعد(2).
أعزائي الحضور ..
لعله استوقفكم هذا التصرف الحكيم الرحيم، حين أخذ الراية من سعد وأعطاها لابنه، فلوا أعطاها لشخص آخر لتأثر ولحزن، أمَّا أن يأخذها ولده فهذا أمر يسر الأب كثيراً، ويسر الابن كذلك، فكان هذا التصرف رحمة من النبي (صلى الله عليه وسلم) بالوالد وبالولد ، ومن بعدُ بأهل مكة كلهم، إنها الرحمة الحاضرة في كل المواقف صغيرها وكبيرها.
يدخل النبي (صلى الله عليه وسلم) مكة، ويجد أهلها مجتمعين حول الكعبة ينتظرون مصيرهم، وما عسى أن يفعل بهم النبي (صلى الله عليه وسلم) وهم الذين آذوه، وأخرجوه، وقتلوا أشخاصاً من أحب الناس إليه، وإذا بالنبي (صلى الله عليه وسلم) يقول لهم: ما ترون إني فاعل بكم؟ قالوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم، فقال لهم أذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم(1).
أذكر في هذا المقام كلاماً كنت قرأته لبعض فلاسفة الغرب من أمثال هوبز ونيتشه، الذين بنوا الأخلاق على دعائم القوة، فهم يرون أن الرحمة حميدة، لأنها مظهر من مظاهر قوة الشخص، الذي يرحم من هو أضعف منه، وبينةٌ على استعلائه على أن يلقى الضعيف بما يلاقي به الأنداد الأقوياء)(2).
لو اطلع هؤلاء على سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) لربما أعادوا صياغة هذه النظرية، لأنهم سوف يرون أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يلاقي الأقوياء الأنداد بالرحمة أيضاً، كما يلاقي الضعفاء، وهذا ظاهر من مواقف كثيرة مرت بنا، وهو ما يصعب على كثيرين استيعابه، لأنه مسلك غير مألوف في سير غالبية العظماء.
الرحمة لا غير، كان لها كلمة الفصل، الرحمة التي وسعت أهل مكة جميعاً باستثناء ستة أو سبعة أشخاص أهدر النبي (صلى الله عليه وسلم) دمهم لشدة عداوتهم للإسلام وأهله، ثم ما لبث أن عفا عن أكثرهم، حين كلمه بعض أصحابه بشأنهم.
الكاتب والمؤرخ "واشنجتون ايرفنج" ـ الذي يُعد من أوائل العلماء الأمريكان الذين عنوا بالحضارة العربية وتاريخها ـ تابع أحداث فتح مكة، واستوقفه عفو النبي عن ألد خصومه، فعلق عليه قائلاً ( كانت تصرفات الرسول (صلى الله عليه وسلم) في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل، لا على أنه قائد مظفر، فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه، برغم أنه أصبح في مركز قوي، ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو)(1).
أعزائي الحضور ..
ظهر لي أن ثمة دافعاً قوياً، يكمن وراء هذه الرحمة، إضافة إلى ما سبق ذكره، إنه الحب، نعم إنه الحب، فقد ثبت لي، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يحب مخلوقات الله جميعاً. المؤمن والكافر والحيوان والطير.
إن الحب الصادق، يأتي بالعجائب، وليس من شك في حب النبي (صلى الله عليه وسلم) لأتباعه، أما حبه الخير للكافرين، فقد شهد به القرآن الكريم حين يقول الله لنبيه: (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (الشعراء : 3 )، أي كأنك تريد أن تهلك نفسك من شدة الحزن والأسى، لأن هؤلاء الكفار لم يؤمنوا.
لقد اشتد حزنه كثيراً، وبان أسفه شفقةً منه على هؤلاء، ورحمةً منه بحالهم، لأنه يعلم مصيرهم، إن ماتوا على الكفر، حتى قال الله له : (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (فاطر : 8 )، أي ارحم نفسك يا محمد، ولا يكن حزنك بهذا الشكل، فقد أديت ما عليك، ولم تقصر معهم أبداً.
أرجو من الأعزاء الحضور، البحث عن الحب، في كل موقف مرّ بنا، من مواقف النبي (صلى الله عليه وسلم) المختلفة، وأنا على يقين أنكم سوف تجدونه ماثلاً أمامكم.
وفي مقابل هذا، فإن الكراهية تدمر البشرية، وأترك لكم استعراض شيء من مواقف بعض العظماء وصنَّاع الحروب قديماً وحديثاً.
ولا أدرى هل ستجدون فيها مظاهر الحب، أو مظاهر الكراهية.
في هذه الساعات التاريخية، وعلى الرغم من تتابع الأحداث، تتحرك رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) تجاه أحد أصحابه المقربين، إنه بلال ابن رباح (رضي الله عنه)، الذي كان عبداً في مكة، يعذب فيها على رمالها الحارة بسبب إيمانه، وهو يردد أحد أحد.
هاهو النبي (صلى الله عليه وسلم) يرحم حاله، وكأنه ينظر إلى شريط الذكريات الذي يستعرضه بلال، وهو يدخل مكة بعد سنوات من مغادرته لها، وإذا بالنبي (صلى الله عليه وسلم) يطلب من بلال أن يصعد على ظهر الكعبة ليؤذن للصلاة.
بلال فوق الكعبة يرفع صوته بالأذان، ويردد كلمة التوحيد، التي عُذَّب من أجلها، أنه تكريم ما بعده تكريم، إنها الرحمة من النبي (صلى الله عليه وسلم) ببلال ليرد له كرامته، ويعيد له اعتباره في مجتمع طالما ظلمه، وقسا عليه.
إذا كانت رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) ببلال تثير الإعجاب، فإن رحمته بأبي سفيان تثير العجب، ناصب أبو سفيان النبي (صلى الله عليه وسلم) العداء منذ بداية الدعوة، وكان يتزعم قريشاً في حربها للنبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه، فلما أحضر أبو سفيان بين يدي النبي (صلى الله عليه وسلم) قبيل دخوله إلى مكة، أراد النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يحفظ له شيئاً من كبريائه، رحمة به.
أعلن النبي (صلى الله عليه وسلم) لأهل مكة أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن (1)، فكان لها أثر في جبر خاطره، وحفظ شيء من ماء وجهه، أمام أهل مكة. لأن هذه الساعات كانت بداية النهاية لزعامة أبي سفيان.
فرأى النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه محتاج للرحمة في هذا الموقف، وهو ما كان، ولعل هذا الموقف الرحيم، من النبي (صلى الله عليه وسلم) كان وراء إسلام إبي سفيان، وأدى إلى حسن هذا الإسلام أيضاً في نفسه وأسرته.
أعزائي الحضور ..
يحسن بنا أن نعرض لحادثة وقعت بعد فتح مكة، تشهد لما سبق ذكره، من أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم تكن تدفعه انتصاراته العظيمة إلى الإصرار على تحقيق المزيد منها، وإزالة أية قوة ما زالت أمامه، بأي ثمن كان، كما لم يكن يستغل حب أصحابه، ولا رغبتهم في القتال، لتحقيق شهرة، أو حسم معركة.
حاصر النبي (صلى الله عليه وسلم) والمسلمون الطائف فترة من الزمن، وكانت حصونهم منيعة قوية، وأصيب عدد من المسلمين عند أسوار الطائف، فرحم النبي (صلى الله عليه وسلم) حالهم، وأمر الجيش بفك الحصار، والرحيل، فضج الناس من ذلك، وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف.
أراد النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يشعرهم أنه إنما اتخذ هذا القرار رحمةً بهم لا غير، فقال لهم: (لا بأس اغدوا على القتال، فغدوا فأصابت المسلمين جراحات، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) بعدها إنا قافلون غداً إن شاء الله، فسروا بذلك، وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، ورسول الله يضحك، فقالوا له يا رسول الله أدعُ على ثقيف، فقال: اللهم أهد ثقيفاً وائت بهم)(1).
لقد كان للرحمة أثر بارز في تغيير سير الأحداث، فهذه المعركة حصلت بعد فتح مكة، وبعد أن أصبحت القوة كلها بيد النبي (صلى الله عليه وسلم)، فكان من المتوقع من منظور عسكري أن يصر النبي (صلى الله عليه وسلم) على هزيمة ثقيف، مهما كلف الأمر من خسائر، إذ لا يعقل أن يكسب معركة العاصمة مكة، وتستسلم له قريش بأكملها، ويقف على أبواب الطائف عاجزاً عن فتحها، وتبقى قبيلة ثقيف خارجة عن طوعه.
بيد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) استحضر الرحمة بأتباعه، بسبب ما أصابهم من جراحات، ولم يلتفت إلى رغبتهم في القتال، فهم لهم حساباتهم، والنبي له حساب واحد، وهو الرحمة بهم، وكذا الرحمة بأعدائهم أهل الطائف.
إذ كان يتوقع النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يستسلموا وأن يسلموا، فالمسالة مسألة وقت فقط، فلمَ القتال والقتل إذاً فالرحمة في هذا الميدان أولى، ولقد كان ما توقعه النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقد جاء أهل الطائف مسلمين طائعين، وكفى الله الجميع شر مزيد من القتال.
هذه أعزائي الحضور .. جولة أحسبها سريعة، على مواطن الحرب والقتال في سيرة نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) وأحسبها تحمل رسائل حانية إلى الناس كل الناس.
الرسالة الأولى تقول : الحوار أولاً، والرحمة أولاً، ولتكن الحرب آخر ما يلجأ إليه، كما فعل نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم).
والرسالة الثانية تقول: إن كان ولا بد من الحرب، فلتكن حرباً رحيمة، كما كانت حروب نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) لا يكون الأطفال والنساء وقوداً لها، ولا حتى بعض من يحضرها، وليكن ضحاياها قلة قليلة.
والرسالة الثالثة تقول: لتكن الحرب وسيلة للتقريب بين الناس، وإزالة الحواجز، وتلك هي نتائج حروب نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) لا أن تكون سبباً لمزيد فرقة، ولا لبث كراهية، ولا سبباً لحروب أخرى، لا يعلم لها نهاية.
أتمنى على البشرية أن تقرأ هذه الرسائل، فإنها بأمس الحاجة إليها، وحالها شاهد.
إن كل موقف مما مرَّ بنا، وإن بدا أنه فردي، أو عابر، إلاَّ أنه مظهر من مظاهر رحمة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) للبشرية، وحين يضع هذا الموقف بين أيدي البشرية، وحين يلزم أتباعه بها، فإنه يكون قد وضع سياسة عامة للبشر جميعاً، وهدفها التقارب والتعاون.
لقد نجح النبي (صلى الله عليه وسلم) في تحقيق هذه الأهداف، ونجح أتباعه في الالتزام بها، وفي ممارستها.
والبشرية كلها مدعوة إلى تأملها ، لعلها أن تنتفع بها، فهي كما قلنا، صارت منارات عالمية، لا يحدها زمان ولا مكان، وليست ملكاً لبيئة أو جنس بعينه.
------------------------------
(1) حديث القرآن عن غزوات الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ج1، ص 43، د. محمد بكر العابد، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت
(1) الإرهاب والإرهاب المضاد، ص 14، مرجع سابق
(1) السيرة النبوية، ج2، ص 234، ابن هشام، السيرة النبوية دروس وعبر، ج2، ص 16، الصلابي
(1) انظر بهذا المعني ، صحيح البخاري، باب الشروط في الجهاد والمصالحة، ح 2731
(2) انظر السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ج2، ص 124، وَرَدَّ في غزوة أحد (15) صبياً ، المرجع نفسه، ج2، ص 383
(1) السيرة النبوية، ج4، ص 100، ابن هشام
(2) أرقام تحكي العالم، ص 244، محمد صادق مكي، ط 1 ، 2006م، الرياض
(1) رواه ابو داود في سننه، حديث رقم 2604، وصححه الألباني ، انظر السلسلة، ج7، ص 14338
(1) السيرة النبوية، ج4، ص 100، ابن هشام، السيرة النبوية الصحيحة، ج2، ص 503، د. أكرم العمري
(2) السيرة النبوية دروس وعبر، ج2، ص 16
(1) عبقرية محمد، ص 45، العقاد
(1) السيرة النبوية، ج1، ص 54، الصلابي
(1) عبقرية محمد، ص 60، العقاد
(2) انظر صحيح البخاري، باب مناقب عثمان، ح رقم 3698
(1) الرسول في عيون غربية منصفة، ص 88، الحسيني
(2) المرجع السابق، ص 142
(3) المرجع السابق، ص 190
(1) المرجع السابق، ص 104
(2) المرجع السابق، ص 183
(3) الرسول في عيون الدراسات الاستشراقية المنصفة، ص 292، الشيباني
(1) السيرة النبوية، ص 217 فما بعدها، د. مهدي رزق الله
(1) تفسير الطبري، ج9، ص 235، معالم التنزيل، ج1، ص 425، البغوي
(2) عبقرية محمد، ص 13، العقاد
(1) انفعالات النفس، ص 98 – 99، ديكارت
(2) دستور الأخلاق، ص 213، د. دراز
(1) انظر صحيح البخاري، كتاب الشروط، حديث رقم 4732، وانظر السيرة النبوية ـ دروس وعبر ، ج2، ص 473، فما بعدها.
(1) انظر المستدرك، ج3، ص 277، الحاكم
(2) السيرة النبوية الصحيحة، ج2، ص 477، د. أكرم العمري
(1) انظر السيرة النبوية، ص 569، د. مهدي رزق الله، وانظر المجتمع المدني، ص 179، د. العمري
(2) أخلاق النبي، ص 40، د. الحوفي، مرجع سابق
(1) حياة محمد، ص 233، واشنجتون، مرجع سابق
(1) انظر السيرة النبوية الصحيحة، ج2، ص 479، العمري
(1) زاد المعاد في هدي خير العباد، ج3/497، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الطائف ، ح 4620، السيرة النبوية الصحيحة، ج2، ص 511






.jpg)