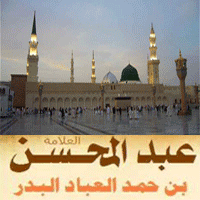إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهده الله فلا مُضل له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ:
فأُوصيكم ونفسي بتقوى الله وتعظيمه وإجلاله وتوقيره، فإنَّ هذه هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [النساء: 131]، وتعظيم الله وتقواه وإجلاله وتوقيره فيها العاقبة الحميدة، وفيها الفوز والفلاح والمنازل العالية والرُّتب الرفيعة في الدنيا والآخرة: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج: 30].
فالله جل وعلا يعظِّم من عظَّمه، وعظَّم أمره ونهيه: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: 60]، ولذا كان على المؤمن أن يتوقف مليًّا عند حاله ومسلكه في تعظيم حرمات الله، وتعظيم أوامر الله ونواهيه، وتعظيم الله جل وعلا وتقديسه، فالعبد يكون كما يكون لربه، من عظم الله عظمه، ومن شكر لله شكر له، وقد أنكر نبيُّ الله نوح عليه السلام على قومه ما كان منهم من الإخلال بهذا الأصل العظيم، وهو توقير الله جل وعلا وتعظيمه وتقديسه وإجلاله، كما أخبر الله عنه أنه قال عليه السلام: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ [نوح: 13].
مالكم لا تعظِّمون الله ولا تُجلونه ولا تُقدِّسونه، بسبب وقوعكم في الحنث العظيم بمخالفة أوامره وانتهاك محارمه، وأعظم ذلك الشرك به تعالى وتقدَّس؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية، وسعيد بن جبير وقتادة رحمهم الله ورضي عنهم في معنى قوله تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾: أي لا ترجون لله ثوابًا، ولا تخافون له عقابًا.
فالمؤمن في تعامُله مع ربه جل وعلا يعلم ما له من صفات الجلال ونعوت الكمال، ويعلم ما له جل وعلا من الفضل العظيم، ويَستحضر أنواع نِعَمه وألوان مِنَنه التي أنعم بها عليه ومنَّ بها عليه، فهو مستحيٍ من ربه، خاضع بين يديه، متطلع لمرضاته، خائف من اقتراف ما يُسخطه جل وعلا، محب لهذا الرب الذي لم تزل نعمه تتوالى وعطاياه تتنوع، فهكذا يكون المؤمن في هذه الحياة بين هذه الأمور حبًّا لربه جل وعلا، وخوفًا من عقابه، ورجاءً لعظيم ثوابه، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن؛ لأن ما يدخل على الإنسان من الوقوع في السيئات والعصيان، إنما هو بسبب ضَعف هذا الجانب، فمن راقب الله ووقَّره وعظَّمه وأجلَّه، بعيدٌ عن أن يسخط الله، وأن يقع في عصيانه، وإذا وقع سارع إلى الاغتسال بماء التوبة والأوبة إلى ربه جل وعلا، فلا يزال يجاهد في هذه الحياة الدنيا؛ يُدافع السيئات، ويُقبل على الحسنات، وإن زلت به القدم بادر بالتوبة لرب الأرض والسموات، ولا يزال على هذه الحال حتى يلقى ربه جل وعلا راضيًا مرضيًّا.
أيها الإخوة الكرام:
إن استحضار المؤمن لهذا الأصل العظيم الذي مداره على التوحيد لله جل وعلا، التوحيد الذي هو أساس العبادات ورأسها، وأعظمها ثوابًا وأجرًا عند الله جل وعلا، التوحيد الذي هو مفتاح الجنة، فلا يدخلها إلا من حقَّق التوحيد لله، فلا يدخلها إلا مَن كان موحِّدًا لله جل وعلا، التوحيد الذي له هذه الثمرات العظيمة، وهو شهود القلب لهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد، فلا يزال متطلعًا لشكرها، مُستَحْيِيًا من ربه في كفرانها، والذي ينبغي على المؤمن أن يربِّيَ نفسه على هذا الأمر، وهو تعظيم الله جل وعلا والاستحياء منه؛ لأن التعظيم يُفضي إلى الحياء من الرب الكريم.
التعظيم الذي يستحضر معه المؤمن عظمةَ الله جل وعلا، عظمته سبحانه التي يشهد معها قلبه بتدبُّره في ملكوت الله جل وعلا أن الله سبحانه على كل شيء قدير، وبكل شيء محيط، وبكل شيء عليم، لا تَخفى عليه خافية وهو على كل شيء قدير، فلا يزال المؤمن في هذا التدبر الذي أمر الله تعالى به، وجعله أمارةً على صلاح القلوب وعلى حُسن مسلك العباد: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُون
هكذا يكون المؤمن مستدلاًّ بعظيم خلق الله على عظمة الله، ويجعله قنطرة لتعظيم الله سبحانه ولتوقيره جل وعلا؛ لأن أكثر الناس لا يقدرون الله حقَّ قدره، ولا يُعظمونه حقَّ تعظيمه، بل إن أكثرهم ربما استحيا واستخفى من المخلوق الضعيف - ولو كان طفلًا صغيرًا - ما لا يستحيي ولا يستخفي من ربه سبحانه وتعالى؛ كما قال سبحانه منكرًا على من كانت هذه حاله: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [النساء: 108].
أيها الإخوة المؤمنون:
إن افتراق الناس في تعظيم الله جل وعلا وفي مراقبته، يكون بحسب ما في قلوبهم من العلم بالله جل وعلا، ولذا قال أهل العلم: من كان بالله أعلم كان له أخوفَ، وإنما يتوالى الران على قلوب كثير من الناس، فيجعلون مراقبتهم لله مراقبة فيها الضَّعف والخَور، وفيها عدم العلم بما لله جل وعلا من صفات الجلال ونعوت الكمال والجلال.
نعم أيها الإخوة المؤمنون، إننا جميعًا بحاجة لأن نتدبَّر ونتأمل حالنا في هذا المسلك، هل نحن معظمون لله حق تعظيمه؟ هل نحن مُجِلُّون لله سبحانه حق إجلاله؟ مع أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية توالت في تقرير هذا الأمر ولفت الأنظار إليه، وأن أكثر الناس لا يقدرون الله حق قدره، ولا يشكرونه حق شكره، ولا يقومون بعبادته كما يجب له جل وعلا، ومما جاء في هذا الباب من الآيات المتكاثرات في تقريره وتأكيده، قول رب العزة سبحانه: ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: 65]، جاءت هذه الآية في سياق بيان ما لله سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال، لَما نزل قوله سبحانه: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64].
نزلت - كما جاء في صحيح البخاري - لَمَّا تطلَّع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يكون نزول الوحي عبر جبرائيل عليه السلام متواليًا كثيرًا، وألا يبطئ عنه، لِما يجده عليه الصلاة والسلام من الأنس بالقرب من ربه ووحْيه، فقال جبرائيل عليه السلام: إن نزوله إنما هو بأمر الله؛ كما في هذه الآية: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64]، ثم قال الله معظِّمًا لنفسه العظيمة الكريمة: ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [مريم: 65]، فربوبيته جل وعلا للسموات والأرض، وكونهما على أحسن نظام وأكمله، ليس في ذلك غفلة ولا إهمال، ولا سُدًى ولا باطل، ولا من خلل في هذا النظام الكوني العظيم الذي يُدركه العلماء، وبخاصة المتخصصون في شأن الفلك.
هذا العالم العلوي والعالم السفلي، والذي لا يزال أهل الاختصاص يستدلون على عظيم جهلهم بما يكتشفون من مجاهيل هذا الكون العظيم الذي لم يُدرَك منه إلا شيء يسير في كواكبه ومجرَّاته، وعوالمه التي لا تُدرَك، وما نحن في هذا الكون إلا كهباءة يسيرة في فراغ نشاهده، فكل ذلك يحمل المؤمن على تعظيم مَن خلَق هذه العوالم العظيمة العلوية والسفلية، خلقها على أعظم نظام وأكمله وأدقه، وذلك كله برهان قاطع على علمه الشامل جل وعلا، وهذا يحمل المؤمن على أن يشغل نفسه ويحملها على تعظيم مَن هذا شأنه: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: 57]، فواجب على المؤمن حينئذ أن يكون كما قال الله: ﴿ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ﴾ [مريم: 65].
اعبده بتوحيده؛ لأن التوحيد هو أساس الأعمال، ومحاذرة الشرك الذي إذا دخل في عمل أحبَطه وأفسده، ولأن هذه العبادة ليست بالشيء الذي يُدَّعى ولا بالشيء الذي يُتَزَيَّا ويُتزَّينُ به دون حقيقة، وإنما هي أمور تحتاج إلى مجاهدة؛ قال الله: ﴿ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ﴾، وقوله: ﴿ وَاصْطَبِرْ ﴾ معنًى أعلى من مجرد الصبر، لم يقل: اصبر لعبادته، وإنما: ﴿ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ﴾؛ لأن هذا يحتاج معها المؤمن إلى نوع من المجاهدة، فكثير من الأمور لا تتوافق مع اتجاه النفس الأمَّارة بالسوء، لا بد من مجاهدة، ومن عظيم إنعام الله وإكرامه أن المؤمن إذا جاهد نفسه على عبادة من العبادات، صارت سجيَّة له ومجالاً لراحته وطُمَأْنينته، فلا يزال ملازمًا لها، فهي عقبة يحتاج أن يجاوزها بالصبر والاصطبار والمجاهدة، حتى إذا ألِفتْها نفسه، وجد فيها راحتها، ووجد فيها طمأنينتها، ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون في هذا المقام، حتى صارت العبادات راحة لنفسه وبهجة لقلبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، ألا ترون كيف أنه كان يقول لبلال رضي الله عنه إذا قرب وقت الصلاة: ((أرحْنا بها يا بلال))، أرحنا بها إنها بهجة النفس وراحة الروح، ذلك أن المؤمن يكون أقرب ما يكون إلى ربه في صلاته، وبخاصة في سجوده، وإنما يجد هذه اللذة ويَستأنس بها مَن صبر وصابَر حتى وصل إليها، على خلاف ما قد يكون لبعض الناس يجد في الصلاة حبسًا لرُوحه، فلا يزال كالمصفَّد حين يقوم في الصلاة، حتى ينصرف منها، وهذه واللهِ عقوبة عظيمة أن يكون الإنسان في حال أدائه للعبادة شاعرًا بالتأفُّف والضيق والحسرة، وإنما هو حصْرُ الشيطان وتسلُّطه عياذًا بالله من ذلك، والمقصود أن الله جل وعلا لما نبَّه عباده على عظيم ملكوته - ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ - حثَّهم على أن يَصطبروا على عبادته؛ ﴿ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾، وهذه الآية أيضًا فيها حثٌّ على أن يَستحضر الإنسان عظمةَ ربه جل وعلا.
﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾: المعنى هل تعلم له شبيهًا ونظيرًا في صفاته العظيمة وكمالاته الجليلة، وما له جل وعلا من صفات الجمال والكمال، ونعوت الجلال، وهذا أسلوب كما يُسميه العلماء هو استفهام إنكاري يفيد النفي، لا سَمي لله، ولا نظير ولا شبيه، ولا نِد ولا مثيل، ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾.
ومن أهل العلم مَن يقول أيضًا: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾؛ أي: أحدًا يناظره في أسمائه سبحانه وتعالى، وبخاصة اسمه الذي جعله لنفسه، فلم يشاركه فيه أحد أبدًا، وهو الله جل وعلا، ومن أهل العلم مَن يقول: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾؛ يعني: تسميه جل وعلا بالرحمن، فلا يُعرف ولا يُوجد مَن يتسمَّى بهذا الاسم أيضًا.
ومهما يكن، فالمقصود: هل تعلم لله مساميًا ومشابهًا ومماثلًا من المخلوقين؟ لا يوجد شيء من ذلك؛ لأنه الرب جل وعلا وغيره مربوب، ولأنه سبحانه الخالق وغيره مخلوق، ولأنه جل وعلا الغني من جميع الوجوه، وغيره فقير بالذات من كل الوجوه، ولأنه سبحانه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وأما غيره فناقص ليس له من الكمال إلا ما أعطاه الله جل وعلا، فهذا يوجب على المؤمن أن يكون مستقيمًا على هذا المنهاج في تعظيم الله وتوقيره وإجلاله، وألا يكون داخلًا في عداد الغافلين الذين أنكر الله عليهم؛ كما في الآية الكريمة: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ [نوح: 13].
بارَك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي نبيه الكريم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ:
فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن النفس البشرية بطبيعتها وجِبلَّتها التي خلقها الله جل وعلا، فيها حاجة إلى التوجه إلى القوي الذي تشعر معه بالْمَنعة والقوة، وفيها حاجة وضرورة فطرية بأن تركن إلى الغني الذي لا تشعر معه بحاجة ولا عجز، ولا إلى غيره من أحد، ولا يكون ذلك إلا بركونها إلى الله جل وعلا، وتوجُّهها بالنفس إلى الرب سبحانه وتعالى، فمن فقد هذا الطريق، واختلت بوصلته في هذا السبيل، يعاني في هذه الحياة أنواعًا من المعاناة.
إن الله سبحانه هو خالق هذه النفس، وهو الذي جبَلها، كما أنها تحتاج إلى التنفس والأكسجين، ولا يمكن أن تعيش بلا ماء ولا طعام ولا غذاء، فكذلك لا يمكن أن تهنأ هذه الروح إلا بركونها إلى الله سبحانه وتوجُّهها إليه، ومهما جُعِل بين يديها مِن مُتَع الدنيا، فإنها لا تفيد شيئًا طالَما بعدت عن زادها الروحي، وهذا الزاد الروحي يتفاوت الناس في تحقيقه، فكلما ترقَّى الإنسان في معارج العبودية، وجد من طمأنينة النفس وراحة البال بحسب قُربه من ذي الجلال والكمال سبحانه وتعالى.
إن هذه النفس فيها خوف لا يسكن إلا بأمرها - بقربها من ربنا جل وعلا - وهذه النفس فيها ضَعف لا يقوى إلا بتوجُّهها إلى الله سبحانه، وهذه النفس البشرية فيها وَحشة لا تُطرَد إلا بالإقبال على الله جل وعلا، وهذا ما يُفسِّر ما يجده كثير من الناس في عالَمنا اليوم وفي كل زمان ومكان من كثرة العلل النفسية والعُقَد الروحية التي تجعل الحياة كئيبة بئيسة، مهما تزخرَفت وتزيَّنت، لكن المؤمن الذي قرب من ربه سبحانه، وترقَّى في معارج العبودية، وعظَّمه الله بتعظيمه، وأجلَّه بإجلاله - يجد في هذه الحياة طمأنينة وراحة لا يمكن وصفها، ولا يمكن تحصيلها بأي شيء مِن مُتَع هذه الدنيا، فهي راحة الروح، وبهجة النفس، وطمأنينة القلب، وهذا قد أشارت إليه آيات كريمات وأحاديث نبوية شريفة؛ قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: 28].
ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ذاق طعم الإيمان مَن رضِي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًّا)).
فهذه النفس بحاجة إلى أن تترقى في عبودية الله جل وعلا وتعظيمه؛ حتى يكون الإنسان مرتاحًا مطمئنًا في هذه الحياة، وإن فاته ما فاته مِن مُتَعها الحسية، أما إن كان المرء على غير ذلك وبضده، فإنه لن ينال في هذه الدنيا إلا مزيدًا من الكآبة والخسران، فإن الله قال - وقوله الحق -: ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ [الحج: 18].
من أهانه الله لو اجتمع أهل السموات والأرض على أن يكرموه ما استطاعوا، ولو حاز كنوز الدنيا ليجدَ بها اللذة والهناء، فإنه لن يُفلح في ذلك؛ لأن هذا هو حكم الله، وقوله الحق: ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾.
وأنتم أيها الإخوة المؤمنون تجدون ذلك واضحًا ملموسًا، فأنت في شعورك بعد أدائك للعبادة غير ما يكون قبلها، حينما تخرج من هذه الصلاة تجد بهجة وراحة، ليس لها تفسير إلا هذه الصلة بالرب سبحانه وتعالى، وهنا يعرف السر فيما يجده أهل الصلاح والاستقامة من الراحة ومن البهجة في نفوسهم، وليس بهذا بمال ولا جاه ولا منصب، وإنما هو بصلتهم بربهم جل وعلا، والناس يتفاوتون في هذا كما بين السماء والأرض، كما أنهم يتفاوتون في حسن العاقبة لذلك في الجنة، فالجنة درجات فيها مائة درجة، ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، وهذا التفاوت راجعٌ إلى تفاوُتهم في تعظيمهم لله وإقبالهم على عبادته في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، فمَن أحسَن، أحسَن الله إليه، ومن قصَّر جاءه جزاء تقصيره جزاءً وفاقًا، ولا يَظلم ربك أحدًا.
اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِل الكفر والكافرين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربَّوْنا صغارًا، ربَّنا هبْ لنا من أزواجنا ومن ذُريَّاتنا قُرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا.
اللهم بمنِّك وفضلك لا تدَع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دَينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مذنبًا إلا إليك رددته برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار.
اللهم إنا نسألك الأمن والطمأنينة.
اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والطمأنينة.
اللهم عظِّمنا بتعظيمك.
اللهم أصلح أحوالنا وأصلح فساد قلوبنا، ورُدَّنا إليك ردًّا جميلاً يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أدم على بلادنا الأمن والطمأنينة، وصلاح الأحوال يا رب العالمين.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا.
اللهم وفِّق ولي أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين.
اللهم ثبِّت أقدام جنودنا المجاهدين المرابطين على الحدود، وفي داخل البلاد.
اللهم اجْزِهم خير الجزاء، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم.
اللهم اكتب لهم الأجر في رباطهم وجهادهم يا رب العالمين.
اللهم اخذل الحوثيين وأعوانهم، اللهم اخذلهم، اللهم اشدُد وطْأَتك عليهم، وانصرنا عليهم يا رب العالمين.
اللهم عجِّل بالنصر لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان.
اللهم وخُصَّ بذلك إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين.
اللهم انصرهم على اليهود والصهاينة المحتلين الغاصبين يا رب العالمين.
اللهم عجِّل بالفرج لإخواننا المبتلين في كل مكان.
اللهم عجِّل بالفرج والنصر لإخواننا المبتلين في الشام، وفي غيرها من البلاد يا رب العالمين.
اللهم انصُر مَن نصَر دينك، واخذل مَن خذَل دينك.
اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم اكْفِنا والمسلمين شرورهم يا رب العالمين.
اللهم احقِن دماء المسلمين في كل مكان.
اللهم احقِن دماء إخواننا في الشام وفي ليبيا ومصر، واليمن وفي بورما، وفي كل بلادك يا رب العالمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين.
سبحان ربنا ربِّ العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين.
http://www.alukah.net/we



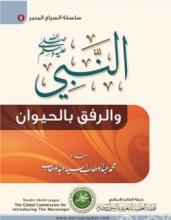


.jpg)