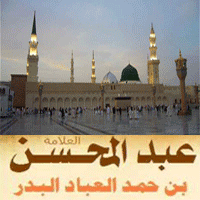مها الجريس
خـلـق الله تعالى الإنسان وخلق فيه نوازع الخير والشر معاً ولم يُرد منه أن يكون ملَكاً يمشي على الأرض، بل جاءت نصوص القرآن والسنة تؤكد هذه النظرة وتدعو المرء إلى التوبة كلما غلبته نفسه الأمارة بالسوء أو استهواه الشيطان وقرناء الشر، ليكون التفاضل في الإسلام ليس بين من يخطئ ومن لا يخطئ، ولكن بين من يتوب ومن لا يتوب، وذلك حين قال صلى الله عليه وسلم (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)[1]. ومن هنا فنظرة الرحمة بالعصاة أصل من أصول الإسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك أروع الأمثلة، فلم يكن يعطي صكوكاً للغفران ولا يملك حقّ حرمان أحدٍ من الجنة وليس لديه كرسي اعتراف. بل كان يدعو العاصين للستر على أنفسهم وإخفاء الذنب بينهم وبين ربهم ويتوبوا إليه سبحانه ليس بينهم وبينه أحدٌ من البشر، داعياً إياهم بعد ذلك إلى أن يظلوا إخوةً لا يسخر أحد منهم من أخيه لأنه و قع في ذنب ٍما أو أن يزكي أحد نفسه أو يتألّى على الله فيظن أن فلاناً لا يغفر الله له.
إن الشعور بالكره من الآخرين يولد في النفس جرأة على تكرار الخطأ والتمادي فيه، ولهذا كان ينهى عليه الصلاة والسلام أن يسب أحد من الناس شخصاً يتعرّض للعقوبة الشرعية بسبب معصية وقع فيها. وحين جيئ إليه برجل يشرب الخمر وقد جُلد فيها مرات قال بعض الناس: قبّحهُ الله ما أكثر ما يؤتى به، نظر إليه صلى الله عليه وسلم مستنكراً وقال: (لا تلعنوه)[2]، وقال مرة (لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم). أما حين يأتيه أحدهم معترفاً نادماً فإنه يأمره بالستر على نفسه فإن أبى إلا أن يطبق عليه الحدّ فإنه يحيطه بالرحمة في أمر تطبيق الحد حتى إنه لما بلغه أن رجلاً جزع من الحجارة في الرجم تمنى لو تركه الصحابة لعله يتوب أو يعود إلى رسول الله فيستعلم منه ما يمكن أن يكون سبباً في درء الحد عنه وذلك كما جاء في قصة ماعز رضي الله عنه. فعن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم فيّ كتاب الله، فأعرض عنه حتى جاء أربع مرات فقال: اذهبوا به فارجموه. فلما مسته الحجارة جَزِع فاشتدّ. قال: فخرج عبد الله بن أنيس من باديته فرماه بوظيف حمار فصرعه ورماه الناس حتى قتلوه. فذُكِر للنبي صلى الله عليه وسلم فِرَارُه فقال: (هلا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه)[3].
وحين جاءته تلك المرأة لتعترف بالزنا أمرها أن تستر على نفسها فتصر وتخبره أنها حبلى من الزنا فيأمرها أن تصبر حتى تلد طفلها ثم حتى ترضعه وتفطمه ثم إذا ماتت بعد أن أقام عليها الحد الشرعي قال عنها: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى)[4]. بل أكد أن من يتجرأ على رحمة الله فيقول بحرمان أحد من الناس منها هو أولى أن يحبط عمله لأنه يتصرف فيما لا يملك. وحدثنا أن رجلا من بني إسرائيل كان له صاحب يشرب الخمر فينهاه ولا ينتهي حتى قال ذات يوم: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: (من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك)[5].
إن مقاييس البشر تضيق عن رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذا فقد كان أرحم الناس بالناس وأرحم الناس بالعصاة مهما بلغت درجة معصيتهم، بل إنه كان يتلمس لهم العذر ويرشدهم إلى التوبة بألطف الأقوال وأقربها للنفوس. جاءه شاب من الشباب تفور فيه الغريزة وتتقد فيه الشهوة فوقف على باب المسجد وقال: يا رسول الله إئذن لي بالزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: (أدنُ)، فلما اقترب قال: اجلس فجلس أمامه صلى الله عليه وسلم حتى جعل يديه على فخذيه وقال: (أتحبه لأمك؟) قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: (ولا الناس يحبونه لأمهاتهم.قال: أفتحبه لأختك؟). قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال: (ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟) قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال: (ولا الناس يحبونه لأخواتهم ، قال: أفتحبه لعمتك؟) قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال: (ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك؟) قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال: (ولا الناس يحبونه لخالاتهم)، قال: فوضع يده عليه وقال: (اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه قال: فلم يكن ذلك الفتى يلتفت بعدها إلى شيء)[6].
إن المتأمل لهذه الواقعة ليعجب من فيض الرحمة المهداة للخلق عليه الصلاة والسلام ومن حكمته وحلمه، فها هو ينادي ذلك الشاب ليقترب منه ويجلسه أمامه ويحاوره بعقله لا بشهوته. يحاوره حوار الأب المشفق ثم يمسح على صدره ويدعو له ليسكن قلبه ويستجلب طاعته ورضاه دون أن ينهره أو يعاقبه أو يلومه على جرأته أمام جمع من الناس حين تجرأ ليطلب الإذن بأمر مقطوعٌ بتحريمه في القرآن بآيات محكمات واضحات. لقد كان أباً رفيقاً بالمؤمنين ولهذا فإنه يحاور ليقنع لا يزجر ليمنع فقط، لأنه يعلم أنه ميت ودينه خالد، والدين لا يؤخذ إلا بعلمٍ وفقهٍ وإيمانٍ لا يتزعزع. إنه هنا يربِّي في نفوسهم سُلطة الضمير، ومراقبة الله تعالى في أحوالهم كلها. إذ الأمر لا يقتصر على مجرد الإذن بالمنكر، فالفساد المترتب عليها حاصلٌ ولو كانت بإذن، لقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى معنى جميلٍ في هذا الحوار وهو الإحساس بالآخرين وتقدير معاناتهم واحترام العلاقات الإنسانية والحفاظ عليها من الانهيار بسبب الإباحية المحرمة. إن حياة الطهارة وحدها هي ما يحقق السعادة للفرد والمجتمع. إنه أعظم مربٍ للروح، وليس قائداً عسكرياً فظاً يلقي أوامره جزافاً ويحرسها بعصا العقوبة وحدها.
ولهذه الرحمة العميمة لم يكن العصاة يهابونه صلى الله عليه وسلم ولا يجدون حرجاً في أن يبوحوا له بمكنون نفوسهم ويعترفوا بذنوبهم راجين دعاءه واستغفاره فقد جاءه أحدهم ذات يوم ليقول له: يا رسول الله أصبت من امرأةٍ كلّ شيءٍ إلا أني لم أجامعها. فقال (اشهد معنا الصلاة) فلما انصرف من صلاة العصر قال: (أين السائل آنفا) فقال: أنا يا رسول الله فقال: (إن الله قد أنزل أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفَاً مِنَ الَّليْلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيـِّئـَاتِ
وحين أفشى رجل من المسلمين لقريش خبر عزمه صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهو (حاطب بن أبي بلتعة) أراد الصحابة أن يعاقبوه لأن فعله في عرف القانون خيانة عظمى، لكنه صلى الله عليه وسلم ناداه وسأله: (ما حملك على ما صنعت؟) وحين أخبره أنه أراد بذلك أن تكون له يد على قريش يحمون بها أهله وولده وهم ليسوا من قريش، قبل منه عذره وعفا عنه. وحين اعترض عمر رضي الله عنه على ذلك قال: (دعه يا عمر فإنه قد شهد بدراً وما يدريك، لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم)[8]، والقصة عند البخاري بتمامها وفوائدها. إنها الرحمة التي لا تجعل الغضب يسبق على صاحبه فينسيه ما كان من هذا الرجل من خير وجهاد في سبيل الله. وأين تلك الرحمة في هذا الموقف لو لم تكن من عند أرحم الراحمين سبحانه وتعالى الذي أرسل محمداً عليه الصلاة والسلام ليكون رحمة للعالمين.
ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بالعصاة أنه لم يكن ينكر عليهم علانية، وإنما يوجه النصيحة لعامة الناس بطريقة غير مباشرة فكان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا من غير أن يسميهم، وذلك تأسيس لمنهج الإسلام في النصح القائم على الستر والإحسان لا على الفضيحة والتعيير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل له قلت كذا وكذا قال: (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا)[9]. وكان يستخدم معهم أسلوب التربية بطريقة غير مباشرة ولم يكن يفضح كذبهم في تبرير معاصيهم ولو علم خلاف ذلك. ومن أمثلة ذلك أن شاباً كان يجالس النساء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك مستنكراً عليه فعلته فزعم أنه كان يريد منهن أن يفتلن له حبلاً لجمل له شرود، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يعلم أنه لم يكن كذلك فتلطف معه حتى هداه الله لترك هذا الأمر الذي لا يرضاه الإسلام. كان خوات بن جبير الأنصاري جالساً إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه رسول الله فقال: (يا أبا عبد الله مَالَكَ مع النسوة؟) فقال: يفتلن ضفيراً لجمل لي شرود. فمضى رسول الله لحاجته ثم عاد فقال: (يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟) قال خوات: فاستحييت وسكت، فكنت بعد ذلك أتفرر منه حتى قدمت المدينة فرآني في المسجد يوماً أصلي فجلس إلي فطولت. فقال: (لا تُطَوِّل فإني أنتظرك). فلما سلمت قال: (يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟) فسكت واستحيت فقام، وكنت بعد ذلك أتفرر منه حتى لحقني يوماً وهو على حمار وقد جعله رجليه في شق واحد.
فقال: (يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟) فقلت: والذي بعثك بالحق ما شرد منذ أسلمت فقال: (الله أكبر، الله أكبر، اللهم اهد أبا عبد الله)، فحسن إسلامه وهداه الله[10].
ومن مظاهر رحمته عليه الصلاة والسلام بالعصاة أنه كان يقبل منهم ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى وكان يقول: (إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم)[11]. وقد كان المنافقون يتخلفون عن الجهاد ثم يأتون فيعتذرون بأعذار كاذبة فيسكت عنهم ويتقبلها منهم ويعرض عن ملامتهم، وكذا حاله مع المؤمنين إذا قصّر أحدهم فلم يكن يعاتبهم حتى يسمع معذرتهم. وكان يستغفر لهم كما في القصة المشهورة عن الثلاثة الذين خلفوا والتي تكشف عن مدى رحمته صلى الله عليه وسلم بالعصاة من المؤمنين وفرحه بتوبة الله عليهم وبشارتهم بذلك. والقصة كما وردت عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو كعب بن مالك رضي الله عنه. فقد ناداه صلى الله عليه وسلم وسأله عن سبب تخلفه ثم أمره أن يقوم حتى يقضي الله في أمره. ورغم مقاطعته وأصحابه للثلاثة الذين خُلِّفُوا، إلا أنه كان يرحمهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان كعب يقول أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلي وأنا أصلي فإذا انصرفت أعرض عني، وكان ينتظر توبة الله عليهم فلما أتاه الوحي من الله بقبول توبتهم أمر البشير أن يسعى إليهم، وأقبل عليهم صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك حتى قال لكعب: (أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك)[12].
إنها الرحمة العامرة التي لا تقنِّط عاصياً ولا ييأسُ معها مذنب مهما أسرف على نفسه، الرحمة التي جعلتهم يفرون من سياط ضمائرهم إلى جنة رحمته ودعائه صلى الله عليه وسلم لهم، الرحمة التي علمتهم أن لا يكرهوا أنفسهم حينما يخطئون بقدر ما يهمُّهم كيف يستفيدون من أخطائهم ويحولونها دروساً إيجابيةً في حياتهم، الرحمة التي تذكِّرهم دوماً أنهم بشرٌ لا يمكن أن يكونوا ملائكة بلا أخطاء وأن الله أرادهم أن يذنبوا ويستغفروا، ولو لم يكونوا كذلك لأذهبهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)[13].
إنها الرحمة التي أدركوا بها معنى عبوديتهم لله تعالى ومعنى كون ربهم سبحانه يغفر ويعفو ويتجاوز. تلك الرحمة التي جعلتهم يتصالحون مع إنسانيتهم ويطمئنون إليها دون شعورٍ بالانفصام، فقد ظن بعض أصحابه رضي الله عنهم أن تغيُّر نفوسِهم من الحال التي يكونون عليها معه نفاقاً وخطأً فأتاه حنظلة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله نافق حنظله! فقال صلى الله عليه وسلم: (وما ذاك؟). فأخبره أنه يجد من نفسه رقةً وصفاءً وروحانيةً عظيمةً حين يكون في مجلسه صلى الله عليه وسلم وأنه يعود إلى بيته وأهله فينشغل بهم ويخرج من هذا الجو الروحاني إلى جو الحياة المادية، فيجيبه صلى الله عليه وسلم أنه لو استمر في روحانيته لكان من الملائكة. وختم حديثه بعبارة موجزة رقيقة تبين فهماً عميقاً للروح البشرية وضرورة التوسط معها والاعتدال في تلبية حاجاتها فيقول: (ولكن يا حنظلة ساعة وساعة). عن حنظلة الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الله ما تقول؟. قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يُذّكِّرُنا بالنار والجنة حتى كأنا رأيَ عين فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما ذاك؟) قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) ثلاث مرات[14].
إنه بحق نبي الرحمة يؤسس منهج الرحمة في تطبيق دين الرحمة. فها هو يعيدها ثلاثاً للتأكيد، ساعة وساعة. فالتوازن مطلوب وهو سر السعادة، بل إنه من رحمته صلى الله عليه وسلم ومراعاته لأحوال النفوس وتقلباتهالم يكن يجعل أيامهم كلها مواعظ ولا مجالسهم كلها تخويف وتذكير، بل كان يقتنص الفرصة المناسبة والحدث المناسب والموقف الملائم ليطرح توجيهاته ويقدم نصائحه رفقاً بالقلوب من اليأس والقنوط وبالنفوس من الملل والسآمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا)[15].
إنه بحق أعظم رحيم عرفه الكون. ولكننا حين نتحدث عن رحمته صلى الله عليه وسلم بالعصاة لا ننسى أن ذلك لا يتعارض مع إقامة الحد وإيقاع العقوبات عليهم والتي فرضت للتطهير والحد من وقوعها في المستقبل لا لمجرد ضبط الفاعل وردعه. فالإسلام في ضبط المجتمع لا يعتمد على العقوبات، ولكنه يصلح الإنسان ويهذبه ويرتقي به بالتربية وتطهير النفس وغرس القيم والمثل والوازع الديني الذي يجعله يتمتع بقوة ضبطٍ ذاتية لا يمكن أن يرقى إليها أي قانون وضعي. ويرافق ذلك تطهير المجتمع من مثيرات الجريمة التي تغري بها، ويحول دون نشوء ظروفها التي تنمو فيها، فيحارب الفقر والمرض والبطالة والإثارة والظلم الاجتماعي. ثم بعد ذلك تأتي العقوبة كرادعٍ لمن تسوِّل له نفسه ارتكاب الجرائم وتهديد أمن المجتمع والدولة. وهي إلى التهديد والزجر أقرب منها إلى إيقاع العقوبة، ذلك لأن الإسلام وضع شروطاً لإقامة الحدود والعقوبات بالغة الدقة؛ توخياً للعدالة ودرءاً للعقوبة ما أمكن، وهي مظهرٌ من مظاهر الرحمة أيضاً. ويمكننا أن نعدَّ على أصابع اليد الواحدة الحدود التي نفذها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك نعلم أن هذه العقوبات التي شرعها الإسلام تتوافق مع أسماء الله وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله، ومع الرحمة التي تمتع بها رسوله؛ لتزول عن الناس النوائب والمكاره، وتنقطع الأطماع والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه.
إن شفقته الواسعة عليه الصلاة والسلام لم تكن لتحول بينه وبين تطبيق الحدود الشرعية. فكان يأخذ بقوة وحزم بوصية الله سبحانه: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ[1
[1] سنن ابن ماجه 4241 وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن بن ماجه (9/251)
[2] صحيح البخاري 6282
[3] سنن أبي داود 3836 وصححه الألباني دون زيادة (لعله أن يتوب) في صحيح وضعيف سنن أبي داود (9/419). والوظيف هو عظم من عظام الحمار.
[4]صحيح مسلم 3209
[5] صحيح مسلم 4753
[6] مسند الإمام أحمد 21185 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/369)
[7] مسند الإمام أحمد 3661 وصححه الألباني في الإرواء (8/23-24)
[8] صحيح البخاري 2785
سنن أبي داود 4156 وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (10/288)
[10] قال الهيثمي: رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير الجراح بن مخلد وهو ثقة
[11] صحيح البخاري 4004
[12] صحيح البخاري 4066
[13] صحيح مسلم 4936
[14] صحيح مسلم 4937
[15] صحيح البخاري 66
[16] سورة النور / الاية 2
[17] صحيح البخاري 3216
[18] سورة البقرة / الآية 179
[19] الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص11-15



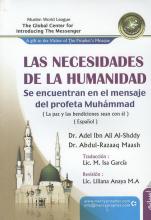


.jpg)