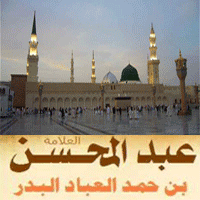إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهده الله فلا مُضل له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومَن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فالحمد لله كثيرًا، والشكر له وحده كثيرًا، له الحمد سبحانه على كل نعمة أنعم بها في قديمٍ أو حديث، في سرٍّ أو علانية، له الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى.
أيها الإخوة المؤمنون، إنَّ المتأمل في دين الإسلام وما جاء فيه من تشريعات حكيمة، وتوجيهات سامية شريفة، يلحظ في كل جزئية منها الخيرَ للناس في معاشهم ومعادهم، فطيبوا بذلك نفْسًا، واهنؤوا بهذه التوجيهات الربانية، وبهذه الشرعة الإلهية التي أنعم الله تعالى بها عليكم، إذ جعلكم مسلمين.
أيها الإخوة في الله، لقد جاءت كثيرٌ من التشريعات الإسلامية التي تحفظ للمجتمع قيامَ كِيانه وتُبعده عن كل ما يضر بأفراده، ومن جملة ذلك حديثٌ نبوي شريف، نعيش وإيَّاكم في هذه الدقائق في ظلاله الوارفة وأفانينه المتدلية، ذلكم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: (اجتنبوا السبع الموبقات)، قالوا: يا رسول الله، وما هُنَّ؟ قال: (الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).
هذا النصُّ النبويُّ العظيم فيه توجيهاتٌ لعمومِ المسلمين أن يجنبِّوا أنفسهم الوقوعَ في هذه السبع التي وصفها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنهنَّ موبقات - يعني مهلكات - وجاء في لفظٍ آخر أنهنَّ الكبائر، ذلك أنَّ من الذنوب ما هو كبيرٌ كما حكمت عليه الشريعة، ومنه ما هو دون ذلك، وإنْ كان العصيان للرب جل وعلا بأيِّ صورةٍ من الصور هو قبيحٌ شنيعٌ شديد، والله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ [الانفطار: 6]، ما غرَّك وجرَّأك على أن تعصي ربك بصغيرة أو كبيرة، ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: 7، 8]، فما الذي يُجرِئُك على مَنْ هذه أنعمه عليك، وهذا فضله عليك، ولا قِوام ولا بقاء لك إلا به، فلا جرم أن كل صغيرة وكبيرة قبيح أنْ يتوجَّه بها الإنسان إلى ربه الخالقِ المنعمِ المتفضل، لكنَّ الله جل وعلا من فضله وإحسانه أنَّه يعفو ويصفح، وبخاصة فيما يتعلق بالذنوب الصغائر، والعلماء يفرِّقون بين الكبائر والصغائر كما ذكروا ذلك في مصنفاتهم.
فالله سبحانه يتجاوز عن الإنسان ما تَزِل به قدمُه، وما تغويه به نفسه الأمارة بالسوء؛ لأنَّ الإنسان ليس بمعصوم، ولذا قال الله جل وعلا في شأن عباده المؤمنين وهو يثني عليهم: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ [النجم: 32]، فاللمم وهي صغائر الذنوب مما يُعفى عنه ويُتجاوز وتُكفِّره الحسنات الماحيات، ويقول رب العزة سبحانه: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [النساء: 31].
فتأمَّلوا في هذا الفضل العظيم والوعد الشريف من الرب جل وعلا: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [النساء: 31]، فالإنسان إذا تجنَّب الكبائر، فإنَّ الله يعفو ويتجاوز عن هذه الصغائر التي تغويه بها نفسُه الأمارةُ بالسوء.
والعلماء رحمهم الله بحثوا في هذا المقام مفهومَ الكبيرة، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: (إنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب، أو لعنة أو عذاب)، وروي هذا أيضًا عن التابعي الجليل الحسن البصري، وقال آخرون كالإمام أحمد: (هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة، أو أوجب به حدًّا في الدنيا)، وقال العلامة الماوردي الشافعي: (الكبيرة ما وجبت فيه الحدود، أو توجَّه إليه الوعيد)، وقال إمام الحرمين: (هي كل جريمة تُؤذِن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة).
وهذا ملحظ كريم من هذا الإمام - إمام الحرمين - كل جريمة: كل ذنب تُجرم به مما نهيت عنه، وفيه قلة الاكتراث بالدين وباطلاع رب العالمين، إنَّه مما يصدق عليه أنَّه كبير؛ ذلك لأن من الناس مَنْ يجعل ملاحظته وخوفه من اطلاع طفل من البشر، أعظم عنده من أن يطلع عليه رب البشر، وحسبك بذلك رقَّةً في الدين، عياذًا بالله من هذا!
وقال بعض العلماء: إنَّ من أحسن ما جاء في تعريف وبيان حدِّ الكبيرة، ما ذكره العلامة القرطبي المالكي في كتابه المفهم رحمه الله أنَّ الكبيرة هي كل ذنب أُطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع - أنَّه كبيرة أو عظيمٌ، أو أُخبر بشدة العقاب، أو عُلِّق عليه الحد، أو شُدِّد النكير عليه، فهو كبيرة.
والنبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: (اجتنبوا السبع الموبقات)، قال العلماء: سُمِّيت بهذا الاسم؛ لأنها سببٌ لإهلاك مرتكبها، ذلك أنَّ الذي يُقارف هذه الذنوب العظام تجرُّه إلى اضمحلال في دينه، وعدم مراقبة لربه، فلا تزال كِفَّة السيئات راجحة متزايدة، والحسنات في قِلَّة وضَعف عن أن يقبل عليها هذا الإنسان؛ لأنَّ الذنوب لا تزال على قلب الإنسان، حتى يُختم عليه عياذًا بالله من هذا؛ قال الله جلَّ شأنه: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: 14].
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يذكر في هذا المقام هذه الذنوب السبع العظام الكبار المهلكات الموبقات، فإنَّه نص على أنها من أكبر الكبائر، وقد جاءت نصوص أخرى وفي مناسبات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصف به بعض الذنوب بأنها من الكبائر، ولذا ذهب العلماء رحمهم الله إلى حصر وعدِّ هذه الكبائر، ولذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّه قال: (هي إلى السبعين أقرب) كما تقدم، وقد ذهب العلماء في إحصائها وألَّفوا في ذلك المؤلفات، كما صنع الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه (الكبائر)، وكما صنع الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتابه (الكبائر)؛ حيث جاءت نصوص أأخرى تذكر غير هذه السبع، ومنها: الانتقال عن الهجرة والزنا والسرقة، والعقوق واليمين الغموس، والإلحاد في الحرم، وشرب الخمر وشهادة الزور، والنميمة وترك التنزُّه من البول، والغلول ونكث الصفقة؛ يعني: الخروج عن بيعة الإمام، وفِراق الجماعة، وهو ما يصنعه الخوارج، فتلك عشرون خَصلة بعداد هذه مع السبع المتقدمة، وهي تتفاوت في شدتها وعِظمها.
والمقصود أنَّه من الذنوب ما هو من الكبائر، فينبغي للمؤمن أن ينأى بنفسه عن ذلك، وأن يعمل بهذا التوجيه النبوي (اجتنبوا)، فيكون هو في جنب وهي في جنب آخر؛ لأن الإنسان إن مات ولم يقترف الكبائر، فإنه إلى مغفرة الله بأمره ورحمته ومشيئته أقرب، وأما الكبائر كما ينص العلماء، فلا بد لها من توبة خاصة.
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث هذه الكبائر، وصدَّر بها الشرك بالله، فهو أعظم الذنوب، وهو أن يجعل الإنسان شريكًا لله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته، وهذا الذنب هو أشنع الذنوب وأعظمها، وهو أظلم الظلم، ولذلك فقد حكم الله تعالى على من مات على الشرك الأكبر أنَّ الله لا يغفر له، وأنَّ الله حرم عليه الجنة، وأنَّ مأواه النار؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة: 72].
وهذا الشرك الأكبر وما ينضوي تحته من الكفر والإلحاد والزندقة، وغير ذلك مما فيه الكفر بالله، هذا مآل صاحبه إن مات عليه، ودون هذا الشرك الأكبر ما يسمِّيه العلماء الشرك الأصغر، وهو ما دون الشرك الأكبر، مما جاء وصفه بأنَّه شركٌ، ولكنه ليس من الشرك الأكبر، وهذا أيضًا جاءت النصوص بالتحذير منه، فهو لا ينقض التوحيد، ولكن ينقص ثوابه، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، والعلماء رحمهم الله يفصِّلون في هذا أنَّ منه ما هو شرك ظاهر، هذا الشرك الأصغر منه ما هو شرك ظاهر، وهو ما يكون في الأفعال والأقوال؛ كالحلف بغير الله؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (مَن حلف بغير الله، فقد كفر وأشرك)، وكمن يجعل الفضل لله قارنًا به الفضل لأحد من الخلق، فيقول: هذا بفضل الله وبفضل فلان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قال هذا القول، وهو يصف ويثني على النبي عليه الصلاة والسلام: (أجعلتني لله ندًّا، قل: ما شاء الله وحدَه).
ومن أنواع الشرك الأصغر الشرك الخفي، وهو الذي يكون في النيات والمقاصد، وهو ما يريد به الإنسان مدح الناس وثناءهم، فهو يصلي وربما دخل عليه ما قد يكون من حُبِّ ثناء الناس، وهكذا في الأعمال الصالحات الأُخر، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)، قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: (الرياء).
والمقصود أن الشرك بكل أنواعه من أعظم الذنوب وأشدها، وأبغضها عند الله جل وعلا، فإنَّه أظلم الظلم وأشنعه وأشده، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقة الثانية وهي السحر، وقد قال العلماء في شأنه: إنَّه عزائم ورُقى، وعُقد تؤثر في الأبدان والقلوب، فيُمْرِض ويقتل، ويفرِّق بين المرء وزوجه، ويأخذ بأحد الزوجين عن صاحبه، ويؤثر في الإنسان تأثيرًا واضحًا، ويتوصل به الساحر بفعله هذا من خلال استعانته بالشياطين وهم لا يعينونه، ولا يؤدُّون له ما يريد إلا إذا كان قد قدَّم لهم ما يريدون من شرك بالله ومن قبائح الذنوب وشنيعها.
وقد أجمع العلماء على أنَّ السحر حرام، وأنَّ تعلُّمه وتعليمه حرامٌ، وأنَّ تعاطيه حرام، وأنَّ الذهاب إلى السحرة أو حضور مجالسهم، أو مشاهدة برامجهم حرام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم أنَّه قال: (من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة)؛ رواه مسلم.
هذا إذا ذهب إليه وسأله ولم يحصل شيء من التصديق، لا تقبل صلاته أربعين يومًا، أما إنْ صدق، فقد جاء فيه النص: (فقد كفر بما أُنزل على محمد عليه الصلاة والسلام)؛ لأنَّ الإنسان إذا صدق الساحر بما يُحدِّث به من أمور الغيب، فقد صدَّق أنَّ غير الله يعلم الغيب، والله جلَّ وعلا يقول: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل: 65].
والمقصود أنَّ السحر من الموبقات المهلكات، والله جلَّ وعلا قد حكم على أهله: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: 69].
وقد يُبلى بعض الناس بتسلُّط السحرة عليه، فيُجعل له ما يُجعل من عمل، فربما ضعفت النفس، فتوجَّه البعض إلى ساحر آخر ليفُكَّ السحر وهذا عمل محرم؛ لأنَّ الباطل لا يعالج ولا يزال بالباطل، وإنما بما ثبت مما دلَّنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالسحر يكون فكُّهُ وإزالته باللجأ إلى الله، ومن ذلك الرُّقى الشرعية، وبخاصة سورة البقرة، وأيضًا أن يحرص على التوصل إلى السحر أين مكانه؟ حتى يُحلَّ ويُفكَّ؛ كما دلَّ على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد يمرر على بعض الناس ما يعقده بعض السحرة من البرامج في الفضائيات، فيظن الناس أنَّ تغيير المسميات بأنَّ فلانًا يقرأ الحظ، أو أنَّه يقرأ الفنجان، أو قراءة الكف، أو أنَّه يتوصل إلى هذه الأمور بالبلورات، والنظر في الكواكب والنجوم والأبراج، إلى غير ذلك من المسميات التي لا تغيِّر من الحقائق شيئًا، فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا، فإنَّ من يتابع شيئًا من هذه البرامج - التي فيها حضور السحرة والكهنة والمشعوذين، والدجَّالين الذين يسمون أنفسهم عرَّافين - فإنَّ حضور ذلك ومشاهدته، يُخشى على صاحبه أن يتناوله هذا الوعيد وهو ألا تقبل له صلاة أربعين يومًا، علاوة على ما يكون من إضعاف التوحيد في نفس الإنسان!
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا من أكبر الكبائر، ومن أشنع الظلم، ولذلك فإنَّ الله تعالى توعَّد من وقع منه هذا - بأن قتل مؤمنًا بغير حق - بالوعيد الشديد، وأنَّ الله قد غضب عليه ولعنه، وأعدَّ له عذابًا عظيمًا، وهذا الوعيد في شأن قتل النفس؛ لأنَّه جُرمٌ عظيم ومخالفة لما أمر الله تعالى به من حقن الدماء، ولذلك عُظِّم القتلُ حتى ولو كان عن طريق الخطأ، حتى ولو قتل إنسان إنسانًا عن طريق الخطأ، فإنَّ هذا عظيم، ولذا جاءت فيه الكفارة؛ كما قال الله جل وعلا: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾ [النساء: 92].
والمقصود أنَّ النفس الإنسانية لها حُرمتها، ومن اعتدى على هذه الحرمة، فإنَّ الله تعالى قد أعدَّ له العذاب العظيم، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إنَّ من ورطات الأمور التي لا مخرج منها - أن يقتل الإنسان إنسانًا بغير حق)، أو كما ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه.
وعظَّم الله هذا الأمر بين البشرية جمعاء؛ كما قال سبحانه في قصة ابني آدم: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32].
وبمثل هذه الأوامر والنواهي تُحقن الدماء، وتُحترم الأعراض، ويسود الأمن والاطمئنان بين الناس، ولذا كان من أعظم بشائع الخوارج استباحتهم للدماء واستسهالهم للتكفير، فإنهم ربما ترددوا في قتل عصفور أو حيوان، لكنهم يتساهلون أعظم التساهل في قتل الإنسان بعد أن يحكموا عليه بالكفر والردة، وهذا من أعظم الضلال.
والمقصود أنَّ قتل النفس من أكبر الكبائر، ولذا حذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، وأبدى وأعاد، حتى إنَّ ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه سائل يسأله: هل للقاتل من توبة؟ قال: لا، وكان منه رضي الله عنه هذا لبيان شناعة هذا العمل، وهذا يوجب على الإنسان أن يكون محاذرًا من الانزلاق في هذا الأمر، فإنَّ كثيرًا من حوادث القتل تكون من عدد من الناس بسبب لحظات الغضب، تحصل مضاربة واختلاف في أمر، فيبادر هذا الإنسان إلى سلاحه أو إلى حديدة أو غير ذلك، فيقتل هذا الذي أمامه، وما يظن أنَّ هذا ليس من الشجاعة في شيء، وإنما هو حمق وتهوُّر سيدفع ثمنه باهظًا.
وقد رأيت مرة عند زيارتي أحد السجون إنسانًا حُكِم عليه بالقصاص، والسبب في ذلك خلافٌ بينه وبين المقتول على ريال واحد فقط، حضره الغضب، ثم قتل هذا الذي أمامه، فندِم ولات ساعة مندم، والإنسان بكل حال لا يصح أن يستبيح دم آخر، ولو أنَّه كان مظلومًا في الملايين، فإنَّ هذ الدم ثمنه أعظم وأجل عند الله جل وعلا.
والمقصود أنَّ الإنسان ينبغي أنْ يتحلَّى بالتؤدة وبالحلم في لحظات الغضب، وألا يظن أنَّ الشجاعة هي إمضاء القوة والقتل والضرب فيمن أمامه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد - الشجاع الحق - هو من يملك نفسه عند الغضب).
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقة الرابعة وهي أكل الربا، والعلماء يعرِّفونه بأنَّه زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خاليةً عما يقابلها من عِوَض، أو أنها زيادة في مال مخصوص.
والمقصود أنَّ الربا وهو مما عظم وطم، ومما وُجِدَ لدى الأمم من قبلنا - محرَّم بكتاب الله وبالسنة والإجماع، ولذا قال الله جلَّ وعلا في كتابه الكريم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، ويقول جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 130].
فلا يعرف في كتاب الله وسنة رسوله أنَّ الله أعلن الحرب على ذنب كما أعلنه في شأن الربا، تأملوا: ﴿ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: 279]، ومن ذا الذي يطيق حرب الله؟! ولذلك لا يُعرف مجتمع شاع فيه الربا إلا وأصابه النقص والوكس، وأُصيب أهله بأنواع من المشكلات المادية.
والعالم اليوم بما يشهده من الضوائق الاقتصادية أبينُ دليل على سوء عاقبة الربا، فإنَّه منذ بضع سنين لما اشتدت الأزمة المالية الخانقة في العالم، كان الرجوع والمخرج منها - وخاصة في الغرب - أنهم قرروا المبدأ الإسلامي، وهو أنْ يرجع الإنسان إلى أصل ما كان التعاقد عليه؛ كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، مقررًا ما ينبغي من التخلص من الزيادة، فجعلوا الزيادة التي اشترطوها من قبل أن يُرجع فيها إلى ما نسبته صفر؛ حتى لا يحصل الربا الذي أرادوه ابتداءً.
والمقصود أنَّ شيوع الربا وتعاطي الإنسان له، لن يزيده إلا خسارًا، فينبغي للمسلم أن يكون محاذرًا من تعاطي الربا، وأن يكون محاذرًا أكثر وأكثر من الأساليب الملتوية التي تطبِّقها بعض البنوك، في أن تعطي الإنسان قرضًا تسمِّيه باسم آخر على أنَّه نوع من المشاركة المالية أو غير ذلك، بينما حقيقتُه الربا، ولذلك كثيرٌ من الناس يغترُّ بهذه المسميات التي لا تغيِّر الحقائق، فإنَّ العبرة بالحقائق والأوصاف وليس بالمسميات.
فالربا من أعظم الكبائر التي ينبغي للمسلم أن يحذر منها، ومن تعاطاه، فلن ينال إلا المحق في ماله وسوء العاقبة في الآخرة، عياذًا بالله من كل ذلك!
أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومَن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقة الخامسة، وهي أكل مال اليتيم، ذلك أنَّ من محاسن شريعة الإسلام الإحسان إلى اليتامى، والسعي في رعايتهم، والقيام على أموالهم بالمعروف، وجاء التحذير من أن تمتد اليد إلى اليتيم؛ لأن اليتيم يظهر للإنسان أنَّه لا محامي له، وأنَّه لا مدافع عنه، فجعل الله نفسه العظيمة الشريفة مدافعًا عن هذا اليتيم، فقال جلَّ وعلا: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الأنعام: 152]، وحذَّر الله من السطوة على مال اليتيم، فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10].
ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الموبقة السادسة، وهي التولِّي يوم الزحف، والمعنى هو الفرار من الجهاد ومن لقاء العدو في الحرب، فهذا ذنب عظيم؛ لأنَّ فرار الإنسان عند مواجهة الأعداء، وخاصة إذا كان في الجيش وفي عداده يؤدي إلى هزيمة المسلمين، قال الله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: 15، 16]، فالذي يولي دُبره، ويهرب عند مواجهة الأعداء، ما لم يكن لإحدى هاتين الحالتين: أن يكون ﴿ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ ﴾ [الأنفال: 16]؛ يعني: أنَّه يناور في الميدان، فهو يذهب إلى الخلف؛ لأجل أن يباغت العدو، أو نحو ذلك، والمعنى أنَّه يناور في الميدان؛ لأجل أنْ يواجه الأعداء وليس مقصوده الفرار، أو ﴿ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ ﴾ [الأنفال: 16]؛ يعني: أن يذهب إلى طرف آخر من الجيش، وإلى جزء منه؛ ليُعينه، ولحاجتهم إليه في هذا المقام، وأما إن كان المقصود الفرار، فهذا هو الجزاء: ﴿ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: 16].
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقة السابعة، وهي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والقذف كما يعرفه العلماء هو رمي الإنسان بالزنا أو ما في معناه، وهذا حماية من الإسلام لأعراض المسلمين، والقذف محرم؛ سواء كان موجهًا إلى رجل، أو إلى امرأة، ولكن جاء النص هنا على المؤمنات المحصنات الغافلات؛ لأنهنَّ أدعى للحماية، ولأنَّ قذف المرأة أشد شناعة، ولأنَّ المرأة ضعيفة الجناب، وربما لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وأيضًا لأنها ربما تذكر في مجلس هي غائبة عنه، وتأملوا أنَّ الوصف هنا بقوله: (المحصنات المؤمنات الغافلات)؛ يعني: أنَّه ليس لها شيء من الخنا والفجور، ولا من تعاطي التبرج والسفور، ثم يأتي هذا ليقذفها بهذا الوصف، فإنَّ ذلك مؤذنٌ بإقامة الحد عليه، وبردِّ شهادته، وهذا ثابت بنص الكتاب العزيز.
قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾
فحمى الله أعراض المؤمنين والمؤمنات من افتراء المفترين، وأوجب على القاذف إذا لم يُقِم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام:
الأول: أن يجلد ثمانين جلدة.
الثاني: أن تُرَدَّ شهادتُه أبداً.
الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس.
فالأصل في كل مسلم ومسلمة السلامة والعفة، ولا يقبل من أحد رمي أحد بالزنا وما في حكمة إلا بشهادة قطعية دقيقة، فاشترط لذلك أربعة شهداء كما قال سبحانه: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ فكان هذا الأمر وهو الرمي بالزنا هو الوحيد الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الأمور التي تحتاج لشهادة الشهود؛ رحمةً من الله بعباده وستراً لهم.
قال الحافظ القرطبي رحمه الله في تفسيره:
للقذف شروط عند العلماء تسعة:
شرطان في القاذف: وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف، إذ التكليف ساقط دونهما.
وشرطان في الشيء المقذوف به: وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد، وهو الزنى واللواط؛ أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي.
وخمسة في المقذوف: وهي العقل والبلوغ والإسلام والحريّة والعفة عن الفاحشة التي رُمِيَ بها كان عفيفاً من غيرها أم لا.
وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من معاني الإحصان لأجل أن الحدّ إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف. انتهى.
وفصّل العلماء في كيفية إدلاء الشهود بشهادتهم على نحو دقيق يكاد ألا يوجد أبداً، حتى قال بعض العلماء: إنه لم يعرف أن حداً للزنا ثبت بشهادة الشهود.
وكل ذلك سمو الشريعة الغراء وتشوفها للستر واحتياطها لأعراض المسلمين والمسلمات، فما أعظم حرمة المسلمين والمسلمات، وما أكرم الله وأرحمه بعباده.
وبعد، فإنَّ هذه الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذَّر منها، هي لأجل أن يحفظ المجتمع في هذه الأمور العظيمة التي يهتم بها الفرد والجماعة، فنسأل الله تعالى أن يحفظ لنا إيماننا وأمننا، وأن يعيذنا من كل فتنة.
ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك، فقال عز من قائل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم وارضَ عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذِل الكفر والكافرين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ووفِّقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رحمن.
اللهم احفظ علينا في بلادنا أمننا وطمأنينتنا، اللهم احفظ علينا كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين.
اللهم وفِّق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبْعِد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين.
اللهم اغفِر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربَّوْنا صغارًا.
ربَّنا هبْ لنا من أزواجنا وذريَّاتنا قُرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا.
الله فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس كربَ المكروبين، واقضِ الدَّين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم بلِّغنا شهر رمضان، اللهم بلِّغنا شهر رمضان، وأعنا على ما تحب فيه يا رحمن.
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
http://www.alukah.net/web/khal



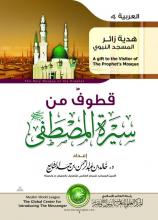


.jpg)