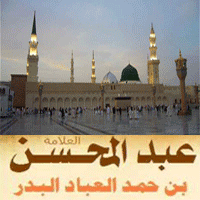الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهده الله فلا مُضِل له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ:
فأُوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن فيها السعادة في الآخرة والأولى، وهي وصية ربنا جل وعلا للأولين والآخرين؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [النساء: 131].
ألا وإن من تقوى الله جل وعلا أن يُعظِّم المؤمن أوامر الله جل وعلا، وأن يُعظِّم نواهيه، وأن يعظِّم شرعه وما جاء في كتابه، وما جاء على لسان نبيه محمدٍ عليه الصلاة والسلام.
ومن سُبل التقوى أن يكون المؤمن مُحاذرًا مما قد يكون فيه التشكيك في شيءٍ من شرائع الدين؛ فإن سبيل التشكيك في شرائع الدين سبيلٌ سلكه المنافقون إبان حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سلَكه المشركون.
وقد عرَض القرآن الكريم عددًا مما كان من شُبهات وتشكيك المشركين والمنافقين؛ كما قال الله جل وعلا في مواضع عديدةٍ في كتابه الكريم، وأخبر، ومن ذلك قوله سبحانه عنهم: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ
والمنافقون سلكوا هذا السبيل أيضًا في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونوَّعوا في شُبهاتهم وما يجعلونه من الأقاويل في شريعة ربِّ العالمين.
ولا زالت هذه الطريق مسلوكةً إلى يومنا هذا؛ إما من الكفار، أو من بعض المسلمين ممن في قلوبهم مرض؛ حيث لا يزال عددٌ منهم يُوالون بين الفَيْنة والأخرى من أنواع الشُّبهات وتَردادها عبر وسائل الإعلام المتنوعة، مما يوردونه من شبهاتٍ لا تخرج عما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المسالك، وبخاصةٍ محاولة بعضهم أن يُشكك في السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عن هذا السبيل، حتى قال - كما ثبت في سُنن ابن ماجه -: ((لعل أحدهم قاعدٌ على أَريكته شبعانَ، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلالٍ أحللناه، وما وجدنا فيه من حرامٍ حرَّمناه، ألا وإن ما حرَّم رسول الله كما حرَّم الله))، أو كما صحَّ عنه عليه الصلاة والسلام.
وهذا ما يُشاهَد اليوم من بعض مَن ليس عندهم علم، وراجت عليهم الشُّبهات، فمرة يُشككون في القرآن، وأن فيه أخطاءً، وذلك لجهلهم وعدم فِقههم وفَهمهم للغة العربية، وعظمة هذا القرآن، ومرات يُشككون في السنة النبوية، وبخاصةٍ حينما يتوجَّهون إلى أصول الإسلام التي جاء بها الصحيحان؛ صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم، يُشككون في أحاديث فيهما، مع أن الأمة قد أجمعت على صحة ما فيهما، وتلقَّتهما بالقَبول، وما من أحدٍ يأتي بشيءٍ من شبهةٍ على هذه الأحاديث الصحاح، إلا والعلماء له بالمرصاد.
والقضية الكبرى هو ذلك الاعتراض على النبي الكريم الذي قال الله تعالى عنه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7].
فيقولون: هذا الحديث وإن كان في صحيح البخاري، لكن العقل يُخالفه، نقول لهم: أي عقل؟ قالوا: عقل المعمل والمختبر للباحث فلانٍ وفلان، بحثوا ووجدوا أن هذا يخالف نص الحديث، مع أن القاعدة المُقررة أنه لا يمكن لعقلٍ صحيح أن يُعارض نقلًا ولا نصًّا صريحًا صحيحًا، فالعقل يُوافق النقل، هكذا هو الأمر المقرر؛ لأن هذه الشرعة من رب العالمين، وهذه المخلوقات لله رب العالمين، فهذا الرد منهم ردٌّ من قِبَل عقولٍ لها حدُّها، لا يمكن أن تُجاوزه.
ولذلك فإن هذه النظريات ربما اختلفت وتغيَّرت، أما شرع الله جل وعلا، فهو ثابتٌ صحيح؛ ولذلك حذَّر الله جل وعلا من رد شيءٍ من كتابه أو من سنة نبيِّه المُطهرة عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله - إذا ردَّ بعض قوله - أن يقع في قلبه شيءٌ من الزَّيغ، فيَهلك، وهذا أمرٌ مُشاهَد، لقد وُجِد في تاريخ الأمة الحديث أقوامٌ قد عُرفوا بحفظ القرآن الكريم، وعُرفوا بالتضلُّع في اللغة العربية، ودخلوا في دراساتٍ وبحوثٍ مُستقاةٍ عن مدارس تُحارب السنة، وتُشكك فيها، فلم يزل يتسلَّل إلى قلوبهم هذا الزَّيغ وهذا التشكيك، حتى ارتدوا على أدبارهم، والعياذ بالله.
أيها الأخوة الكرام، إن الواجب على المسلم أن يكون مُستقِرًّا في قلبه أن ما جاء في كتاب الله جل وعلا حق لا يقبل تردُّدًا، ولا يقبل تشكيكًا، وهذا النبي الكريم إنما هو مُرسلٌ من عند الله جل وعلا، فمعاذ الله أن يأتي بشيءٍ فيه خلاف الحقيقة وخلاف الواقع، معاذ الله أن يأتي بشيءٍ باطل، وربنا جل وعلا يقول: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، وربنا جل وعلا كما حَفِظ كتابه الكريم - ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9] - حَفِظ هذه السنة النبوية، وقيَّض لها رجالًا أكْفَاءً، علماءَ بُصراءَ، نقدوا الضعيف، وميَّزوا الصحيح، ووصلت إلينا السنة واضحةً جلية، ولذلك فإن نصوص القرآن العزيز ونصوص السنة الصحيحة الصريحة في دَلالتها، لا يُعارضها شيءٌ من المعقولات الصريحة؛ لأن العقل شاهدٌ بصحة الشريعة إجمالًا وتفصيلًا، فإذا وُجِد ما يُوهم التعارُض بين النقل والعقل، فمَرَدُّه إلى أحد أمرين؛ إما أن يكون النص غير صحيح، وهذا يَعرفه العلماء - علماء الشريعة، وعلماء الحديث - أو أن يكون العقل غيرَ صحيح، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ديوانٌ عظيمٌ في هذه المسألة، وقد عُلِمت صحةُ الأحاديث، فلم يَبقَ بعد ذلك ألا أن يُوقف على حديثٍ ضعيف، فيتمسك به جاهلٌ، أو عقلٍ ليس مستقيمٍ، فيتعلق به مُتشكك.
يقول الإمام أبن أبي العز الحنفي رحمه الله: إن الشرع لا يأتي بما تُحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تَحار فيه العقول؛ أي: إن الشرع لا يأتي بشيءٍ مستحيل، لكن ربما يأتي أشياءُ تَحتار فيها العقول لعدم العلم بها؛ لأن العقل له حدُّه الذي لا يمكن أن يُجاوزه.
والواجب على المسلم أن يكون هذا الأمر مستقرًّا لديه، وألا يتعرض لهذه الشُّبهات، وإن تعرَّض لشيءٍ منها، فالواجب عليه أن يَلزَم جانب التعظيم للقرآن والسنة؛ ولذا لما جاءت قريش في صَبيحة الإسراء والمعراج إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد علِموا أنه يقول: إنه عليه الصلاة والسلام أُسري به إلى بيت المقدس في ليلةٍ وعاد، فَرِحوا بهذا الخبر، وقالوا: نذهب إلى العاقل الرشيد أبي بكر، ونقول له هذا القول؛ ليعلم كذبَ صاحبه، فما أن عرَضوا عليه، وقالوا: إن صاحبك يقول: كذا وكذا، قال: "إن كان قاله، فقد صدَق، ألا أُصدِّقه بذلك وهو يأتي بخبر السماء".
هذا هو موقف المسلم المُذعن لربه، المُنيب إليه، المُصدق لشرعه، جعَلنا الله جميعًا كذلك.
أقول ما سمِعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
♦ ♦
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحْبه، ومَن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ:
فيقول الله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59].
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون أن الرد في هذه الآية - ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ﴾ - أجمعوا على أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته، واتَّفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته عليه الصلاة والسلام، فإن كان متواترُ أخباره وآحادها، لا تفيد علمًا ولا يقينًا - لم يكن للرد إليه وجْه.
إن كل خبرٍ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - متواترًا كان أو غير متواتر - فالواجب الرجوع إليه، هذا أمر ربنا، ولا يمكن أن يأمرنا الله جل وعلا في هذه الآية بأن نرجع إلى شيءٍ غير موجود.
﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ﴾: إلى كتابه جل وعلا، وإلى ﴿ الرَّسُولِ ﴾: في حياته إبانها، وإلى سنته بعد مماته، أما أن يتركها الله جل وعلا بلا علمٍ ولا بيِّنة، ولا تفصيلٍ ولا هُدى، فهذا مُحالٌ في حق الله؛ لأن الله جل وعلا لم يترك عباده هملًا، ولم يجعل لسبيل الضلال إليهم سبيلًا، فالشريعة بيِّنةٌ واضحةٌ معالِمُها، ولكن مَن تخبَّط وبَعُد عنها، ولزِم العقل، وحارَب به الشرع - فإن الله جل وعلا يَبتليه بالضلال والبُعد عن الصراط المستقيم.
أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا قد أكد هذه القضية، وأبدى فيها وأعاد في كتابه الكريم؛ لأنه جل وعلا يعلم أن من العباد مَن سيأتي بمثْل هذه الأُطروحات المعارضة لشرعه؛ ولذا قال جل وعلا: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36].
وقال جل وعلا: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، ﴿ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ ﴾: إلى كتابه، وإلى رسوله في حَضرته إبَّان حياته، وإلى سنته بعد مماته.
﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: 51].
هذا قول المؤمن، أما مَن في قلبه مرضٌ، فيدخل عليه التشكيك، حتى قال بعضهم: نقبل القرآن، وسَمَّوا أنفسهم: (القرآنيون)، قالوا: هذا القرآن هو الحق، وما سواه لا نَقبله، فإذا عُرِضت عليهم هذه الآية: ﴿ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾، كذَّبوا بها ولم يَقبلوها، فكانوا مكذبين للقرآن، مُحادِّين لله ولشرعه، وكان حقهم الضلال، نعوذ بالله من ذلك كله.
فحريٌّ بنا أيها الإخوة الكرام أن نكون مُحاذرين ممن يشكِّكون، وخاصةً أن منهم مَن يتوجه إلى أعظم دواوين السنة كما تقدم - إلى صحيح البخاري على وجه الخصوص - ويقولون: مَن هذا الرجل حتى نقبل كل ما يقول؟ مَن هذا الرجل حتى يكون له القداسة؟
والحقيقة أنه ليست القضية في قداسة هذا الرجل، وليست القضية في الأشخاص، لكنه علمٌ هيَّأ الله له رجالًا، لم يكن أمرًا غير معروف.
إن سبيلهم وطريقهم، وأسلوبهم ومنهاجهم - واضحٌ بيِّنٌ، يَعرفه العلماء، شهِدوا لهم بقوة الحفظ وسلامة العقل، ومَسلك الرُّشد، إنهم أقوامٌ أطهارٌ، هيَّؤوا أنفسهم لأن يكونوا خادمين للسنة النبوية، فآتاهم الله من العلم والفَهم والحفظ، ما هو من آياته جل وعلا.
هذا الإمام شهِدت له الأمة، وشهِد له العلماء - إبَّان حياته - بسَعة الحفظ، وسلامة المسلك، فما الغرابة أن يكون كذلك في حفظه وربطه؟!
وقد تتابَع العلماء - جيلًا بعد جيلٍ - على تأكيد ما جاء من مسلك هذا الرجل والإمام العظيم، فبات صحيح البخاري تاجًا للسنة، ما أراد أحدٌ قدحًا فيه إلا أظهَر الله عَوار رأْيه، وسوء طَويَّته، وأنه ما أراد خيرًا؛ ولذلك يُرَد عليه باطلُه، فالمؤمن متمسكٌ مُتشبِّثٌ بالسنة، مُحبٌّ لخُدَّامها، مُبغضٌ لمن أنكَرها، أو شكَّك فيها، عياذًا بالله من ذلك.
ألا صلوا وسلموا على خير خلْق الله نبينا محمدٍ، فقد أمرنا ربُّنا بذلك، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفر والكافرين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكانٍ يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا، وسائر بلاد المسلمين.
اللهم أصلح أئمَّتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدِ قلوبهم للإيمان، ووفِّقهم لما فيه خير العباد والبلاد، وارزقهم البِطانة الصالحة الناصحة، وأبعِد عنهم بطانةَ السوء يا ربَّ العالمين.
اللهم اجمع قلوب المسلمين على الحق، اللهم أصلح ذاتَ بينهم، اللهم اجمع فُرقتهم، اللهم يا ربِّ دافِعْ عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان.
اللهم احقِن دماء إخواننا المسلمين في سوريا وفي اليمن وليبيا، وفي غيرها من البلاد يا ربَّ العالمين.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار.
اللهم اغفِر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربَّونا صغارًا.
سبحان ربك ربِّ العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين.
http://www.alukah.net/spotligh



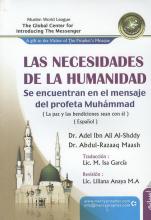


.jpg)